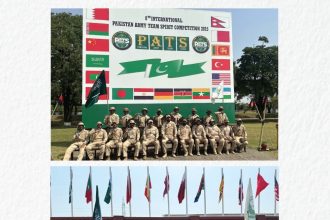قامت دولة الاحتلال جسما غريبا في المنطقة العربية على أساس قرار قانوني من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1947، وهو ما يخلق نقطة ضعف دائمة لها، وهي حاجتها الدائمة إلى الدعم الدولي القوي، كشرط لاستمرار وجودها.
ولذلك فهي تُعِدّ المساس بأسس هذا الدعم تهديدا إستراتيجيا، وتحشد لمواجهته مختلف قدراتها الدبلوماسية والإعلامية والأمنية والاقتصادية.
وتتمثل أسس الدعم الدولي للاحتلال في الدور الوظيفي لها كونها قاعدة عسكرية وسياسية واقتصادية متقدمة للولايات المتحدة وسواها من الدول الكبرى؛ تضمن مصالحهم وتديم هيمنتهم على المنطقة، وتمنع توحد شطريها الآسيوي والأفريقي.
ويستلزم ذلك الحفاظ على الصورة الأخلاقية لدولة ديمقراطية وسط “غابة من الاستبداد والتخلّف” -كما يصوّرون-، وهو ما يعزز الدعم الشعبي لها في غرب استعمر هذه المنطقة، وفرض الانتداب عليها.
وتكتمل هذه الصورة بالاستحضار الدائم لدور الضحية التي تعرضت للهولوكوست على يد الأوروبيين، الذين ينبغي لهم أن يعوّضوا اليهود عن تلك المعاناة على حساب العرب.
مفهوم الشرعية
يرجع أصل الكلمة إلى امتلاك شيء ما صفة القانونية والقبول العام، وبالمنظور القانوني فالشرعي هو ما وافق القانون، أما في مجال السياسة فشرعية نظام ما، هي مقدار ما يناله من طاعة من الشعب، ومن الرضا الداخلي والخارجي.
ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية يرتبط بقاء أي دولة بوجود اعتراف دولي بها، وتعزيز القناعة المحلية والدولية يزيد من قدرة هذا النظام على استخدام القوة، ويعطي قراراته المحلية صفة الإلزامية؛ إذ إنها تُعَدّ تمثيلا لإرادة الشعب.
ولذلك تحرص أنظمة الحكم على اكتساب الشرعية حتى ولو كانت مجرد صورة شكلية، وذلك من خلال الانتخابات والتحالفات الدولية.
أصل الحكاية
في 14 مايو/أيار 1948 أعلن ديفيد بن غوريون ميلاد دولة إسرائيل فوق أرض فلسطين “بموجب القانون الطبيعي والتاريخي للشعب اليهودي، وبموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة” رقم 181 في 1947م، وإعلانه هذا يستند إلى 3 أنواع من الشرعية؛ هي: الشرعية الدينية، والتاريخية، والدولية.
وتقوم دعوى الشرعية الدينية على وعد التوراة نسل إبراهيم -عليه السلام- بأرض، تتفاوت بين حد أقصى هو ما بين النيل والفرات، وحد أدني هو ما بين البحر ونهر الأردن.
ويظهر بطلان كون هذا الأمر أساسا لشرعية الاحتلال، على الأقل لأن نسل إبراهيم يضم العرب أيضا، فلا منطق في تهجير بعض بني إبراهيم لتوطين بعضهم الآخر مكانهم.
بينما تقوم دعوى الشرعية التاريخية على مقولة قيام دولة يهودية على أرض فلسطين قبل 1000 سنة من الميلاد، ولمدة تزيد عن 400 عام، ومما يبطل حجيّة هذه الدعوى قيام دول عديدة قبل هذه الدولة وبعدها، ولمدد أطول، كدول الفراعنة والرومان والمسلمين.
وممن تصدّى لمزاعم الشرعية الدينية والتاريخية لإسرائيل، تيار المؤرخين الجدد، ومنهم المؤرخ والباحث في جامعة تل أبيب شلومو ساند صاحب كتاب ” كيف تم اختراع الشعب اليهودي”.
أما دعوى الشرعية الدولية فتقوم، في بعدها القانوني، على وعد بلفور في 1917 الذي تعهدت فيه الحكومة البريطانية بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وصك الانتداب الذي منحته عصبة الأمم لبريطانيا على فلسطين في 1922، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 في 1947 بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود، وقرارها رقم 273 لسنة 1949 الذي نالت دولة الاحتلال به العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
بطلان الشرعية القانونية
يظهر بطلان الأسس القانونية التي تستند إليها الشرعية الدولية لدولة الاحتلال بشواهد واضحة. إذ أشار الفقيه القانوني اللبناني محمد المجذوب، في مقال له بعنوان “شرعية إسرائيل موضع تساؤل وتخوف من نزعها”، إلى بطلان وعد بلفور قانونيا، وذلك استنادا إلى أسباب منها:
- أن الوعد صدر في 1917، أي في وقت لم تكن لبريطانيا فيه أي صلة قانونية بفلسطين.
- أن بريطانيا أعلنت أن الهدف من احتلالها هو تحرير فلسطين من السيطرة العثمانية، وإقامة حكومة وطنية فيها.
- أن الوعد أعطى فلسطين لمجموعة من مهجّرين أو مهاجرين لا يملكون أي حق فيها.
- أن الوعد ليس اتفاقية بين دول.
- أن الوعد أضر بالحقوق التاريخية والقومية المكتسبة لسكان فلسطين، الذين اعترفت لهم الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى بحق تقرير المصير، وحق اختيار النظام السياسي والاجتماعي الذي يلائمهم.
- أن الوعد يتناقض مع بعض المواد في ميثاق العصبة؛ مثل: المادة العشرين التي تنص على “أن جميع أعضاء العصبة يقرون بأن هذا الميثاق يلغي كل الالتزامات والاتفاقات الدولية المتعارضة مع أحكامه”، وكان على بريطانيا الالتزام بهذا النص وإلغاء وعد بلفور.
- أن الوعد يتناقض مع الوعود البريطانية الواردة في الرسائل المتبادلة بين الشريف الحسين بن علي والمسؤول البريطاني هنري مكماهون، التي تتضمن تعهدا بريطانيا بالاعتراف باستقلال الدول العربية، وإنشاء مملكة عربية. وتلك الرسائل لا تأتي على ذكر الوطن القومي اليهودي.
بطلان قرار تقسيم
كما أجمل المجذوب أسباب بطلان قرار تقسيم فلسطين كما يراها خبراء القانون الدولي بـ3 أسباب؛ هي:
- أن الأمم المتحدة حلّت محل عصبة الأمم كمنظمة عالمية، ولكنها لم تخلفها في صلاحياتها بالنسبة إلى الانتداب على فلسطين.
- أن صلاحيات الجمعية العامة في شؤون الأقاليم الخاضعة للانتداب مقيّدة بأمرين: أحكام صك الانتداب، وأحكام الميثاق الأممي. فليس في إمكان المنظمة العالمية إقرار أي حلّ مخالف لأحكام صك الانتداب الذي نص على انتهاء الانتداب، بإقامة حكومة مستقلة في فلسطين.
- أن الجمعية ملزمة، لدى إصدارها توصيات تتعلق بمصير شعب، باحترام مبدأ تقرير المصير الذي تنص عليه المادة الأولى من الميثاق. وكان من واجبها، عند عرض القضية الفلسطينية عليها، أن تلجأ إلى إجراء استفتاء بين الفلسطينيين لمعرفة رغباتهم. ولكنها لم تفعل.
أما قرار الاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة الاحتلال فقد استند إلى قراري التقسيم وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وهما القراران اللذان لم تنفذهما دولة الاحتلال إلى اليوم، بالإضافة إلى بطلان قرار التقسيم كما تقدم القول.
الصراع حول الشرعية السياسية
وبما سبق؛ يظهر استناد الدول الكبرى إلى منطق القوة وليس منطق الحق والقانون في إقامة دولة الاحتلال والاعتراف بها والدفاع عنها، على ما في ذلك من تناقض مع القوانين والمعاهدات الثنائية والعامة التي عُنيت بالعلاقات الدولية في مختلف مراحل الصراع، باستثناء ما يوافق مصلحة هذه الدول ودولة الاحتلال بالطبع.
وفي المقابل ظهر نضال فلسطيني وعربي وإسلامي وعالمي رافض لشرعية تأسيس وطن لليهود في فلسطين، منذ المناهضة المبكرة للمشروع الصهيوني؛ كما في رفض السلطان العثماني عبد الحميد الثاني مساعي الصهاينة للاستيطان في فلسطين، الذي كان من أسباب الإطاحة به.
وكذلك في الرفض الفلسطيني المبكر لوعد بلفور؛ كما في المؤتمر الفلسطيني الأول في 1919، الذي شارك فيه ممثلون عن مختلف مناطق فلسطين، ورفض مخططات توطين اليهود في فلسطين. وكان هذا الموقف في صلب أسباب الثورات الفلسطينية على الانتداب البريطاني، في سنوات 1920 و1929 و1936- 1939. وكذلك في حرب 1947- 1948.
وعلى المستوى الدبلوماسي عارضت الدول العربية الممثلة في الأمم المتحدة في 1949؛ وهي: مصر والعراق ولبنان وسوريا والسعودية واليمن، قرار الاعتراف بعضوية دولة الاحتلال، واستشهدت بأنها نشأت بطريقة غير مشروعة؛ لأن قرار التقسيم مشوب ببطلان مطلق، وبأن حدودها غير معروفة وغير محددة، وبأنها ليست أهلا لتحمل الالتزامات التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة، لأنها لم تنفذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالتقسيم وعودة اللاجئين وتعويضهم.
هزيمة 1967
وعقب الهزيمة العربية في حرب 1967 أصدر مجلس الأمن الدولي قراره 242 الذي دعا دولة الاحتلال إلى إعادة الأراضي التي احتلتها، “أو أراض كما في النسخة الإنجليزية”.
وعزّز هذا القرار شرعية دولة الاحتلال على حدودها السابقة، دون أن تطبق الشروط التي ارتبطت بقرار التقسيم.
وأصبح التفاوض منذ ذلك الحين يدور حول استعادة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة حديثا، وتطبيق القرار الأحدث لمجلس الأمن. ولم تعترف أي قرارات أممية لاحقة بشرعية الاحتلال الإسرائيلي لهذه الأراضي.
وكان استمرار الثورة وأعمال المقاومة الفلسطينية تحديا مهما للشرعية السياسية لدولة الاحتلال، كونها تقوّض ركنا أساسيا في الشرعية، وهو توفر الرضا والطاعة داخليا، فالمقاومة تعبير عن عدم الرضا، والإضراب والعصيان المدني تعبيران عن ضعف قدرة الاحتلال على إخضاع الشعب الواقع تحت حكمه.
كما استمر الصراع حول ممارسات دولة الاحتلال والحركة الصهيونية على المستوى الدولي، وكان من محطاته البارزة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3379، في 1975 بأن “الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري”.
وطالب ذلك القرار دول العالم بمقاومة الأيديولوجية الصهيونية التي “تشكل خطرا على الأمن والسلم العالميين”، إلا أن هذا القرار ألغي بموجب القرار 46/86 في 1991.
قطار التسوية
وتزامن ذلك مع انطلاق مسار التسوية السلمية للصراع العربي الإسرائيلي، الذي استغلته دولة الاحتلال لنيل الاعتراف بها من كثير من دول العالم، وتطبيع العلاقات مع دول كانت منحازة إلى الحق الفلسطيني والعربي؛ ومنها الصين وقرابة 20 دولة أخرى اعترفت بدولة الاحتلال، أو بدأت علاقتها الدبلوماسية معها في 1992.
فعلى الرغم من أن مصر كانت قد كسرت الإجماع العربي على عدم الاعتراف بإسرائيل بتوقيعها اتفاقية كامب ديفيد للسلام في 1979، فإن ذلك لم يغير موقف غالبية الدول الرافضة لشرعية الاحتلال.
وجاء مؤتمر مدريد واتفاقيات التسوية السياسية مع منظمة التحرير الفلسطينية والأردن لتشيع أجواء القبول بشرعية الاحتلال، وهو ما دفع عشرات الدول إلى الاعتراف بإسرائيل خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي.
وكان من ذلك قبول منظمة التحرير الفلسطينية الاعتراف بإسرائيل، ووقف الكفاح المسلح، وتعديل ميثاقها مما أثّر سياسيا بهذا الصدد، وإن كانت هذه المواقف غير معبّرة عن إرادة الشعب الفلسطيني، الذي أطلق الانتفاضة الأولى بالتزامن مع توجه المنظمة إلى التسوية السياسية مع الاحتلال.
جرائم الاحتلال تنزع شرعيته
استغل الاحتلال أجواء التفاوض مع الفلسطينيين والعرب لفرض الوقائع على الأرض، فضاعف أعداد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس، وتعنت في مواقفه بشأن الأسرى، وأفرط في استخدام القوة ضد أي احتجاجات فلسطينية.
كما شن حروبا متتالية على قطاع غزة عقب انسحابه منه، ولم يلتزم ببنود اتفاقية أوسلو للسلام، وبنى الجدار العازل في الضفة الغربية، وأسهمت هذه الأفعال في تأجيج الرأي العام الدولي ضده، وبروز معضلة “نزع الشرعية الدولية عنه” وهي ما عبّر عنه تقرير معهد ريئوت الإسرائيلي للأبحاث في 2010 الذي أشار إلى المؤشرات التي تثبت ذلك؛ ومنها:
- قيام هيئات دولية كبرى؛ مثل: منظمة العفو الدولية، وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، بتوجيه انتقادات لاذعة إلى إسرائيل واتهامها بانتهاك تلك الحقوق.
- إصدار العديد من مذكرات التوقيف ضد مسؤولين إسرائيليين متهمين باقتراف جرائم دولية، وملاحقتهم أمام القضاء في كثير من عواصم العالم.
- الحملات في أوروبا التي تدعو إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
- المظاهرات المعادية لدولة الاحتلال، في بعض الجامعات في الولايات المتحدة.
- الاحتجاجات ضد التصرفات الإسرائيلية في فلسطين خلال المباريات الرياضية التي تجري في الخارج.
وكان ذلك عقب صدور تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الذي عيّنته الأمم المتحدة رئيسا لمهمة تقصي الحقائق حول العدوان الإسرائيلي على غزة في 2008- 2009، فاتّهم المسؤولين الإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب، وأوصى بإحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا رفضت إسرائيل فتح تحقيق في تلك الجرائم.
قطار التطبيع
على الرغم من الاختراقات التي حققتها دولة الاحتلال خلال عقد التسعينيات بشأن الاعتراف بها، فإن عدم تكاملها الاقتصادي والسياسي والأمني مع المنطقة المحيطة أبقاها في حالة تهديد دائم، ووفّر ظروفا ملائمة لصعود المقاومة الفلسطينية واللبنانية.
وكانت نهاية ذلك العقد قد شهدت تحرير جنوب لبنان، وانهيار مفاوضات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، ثم اندلاع انتفاضة الأقصى، وهي أوضاع أعاقت تقدم مسار الاعتراف العربي بالاحتلال، إذ اشترطت “المبادرة العربية للسلام” تحقيق حل الدولتين لتطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية.
وعلى الرغم من أن هذا الشرط لم يتحقق، فإن العديد من الدول العربية تقدمت في مسار الاعتراف بدولة الاحتلال وتطبيع العلاقات معها تحت ضغط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وإغرائه إياها بتشكيل تحالف عربي إسرائيلي في مواجهة إيران.
وكان من هذه الدول كل من: الإمارات والبحرين والمغرب. بينما كانت السعودية تصدر إشارات بقرب تطبيع العلاقات مع الاحتلال، دون اشتراط تحقيق حل الدولتين.
طوفان الأقصى
وفي هذه الأجواء حصلت معركة طوفان الأقصى، التي أظهرت ضعف الاحتلال أمنيا، وأنه ليس طرفا موثوقا ليكون محور تحالف إقليمي جديد.
وكان لجرائم الاحتلال فيها أثر بالغ في صورته الدولية، إذ كان حجم الاحتجاج الشعبي على جرائمه غير مسبوق في تاريخ الصراع، كما كانت المرة الأولى التي يمثل فيها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
وأعاقت هذه الأجواء مساعي التطبيع الإقليمي، ورفعت كلفة الدعم الغربي لإسرائيل، وأظهرت اختلافا سياسيا حادا بشأن حل الدولتين بين الاحتلال ورعاته الغربيين.
ووصل الأمر إلى أن يصبح الموقف الأميركي من الحرب عاملا فاعلا في حظوظ تجديد ولاية الرئيس الأميركي من عدمه، في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها نهاية 2024.
وبالإجمال يمكن القول إن الفترة الذهبية لشرعية دولة الاحتلال تزامنت مع صعود مسارات التسوية والتطبيع الإقليمي، بينما تراجعت هذه الشرعية بالتزامن مع صعود المقاومة الفلسطينية والعربية للاحتلال. وأن الظروف التي خلقتها معركة طوفان الأقصى تدفع باتجاه إضعاف هذه الشرعية بشكل متسارع، وباتجاه زيادة الرفض للاحتلال وممارساته محليا وإقليميا ودوليا.