سمرقند – كانت وفاة الإمبراطور تيمورلنك عام (1405) حدثا غير العالم؛ فلم يعد هناك غزاة كبار ولا أمراء حرب عالميون يقودون قبائل البدو الرحل ويخرجون من السهوب الأوراسية لغزو العالم على خطى جنكيز خان، بل أصبح سكان وسط آسيا الذين لا يركبون البحر حبيسي الأرض السهلية، بينما تمدد سكان الحواضر والمراكز المستقرة على سواحل البحار والمحيطات لاستعمار العالم بحرا.
في مدينة سمرقند العريقة، كما غيرها من مدن آسيا الوسطى، يرى الناس “سيف الإسلام” كما سمى تيمور نفسه، فاتحا عظيما وينظرون إليه نظر المقدونيين للإسكندر الأكبر، وبينما كان يشرح دليل سياحي سمرقندي سيرة تيمور وأعماله “الحضارية” التفتَ إلي بغتة وقطع حديثه بالأوزبكية التي لا أفهمها كثيرا، ليستدرك بعربية مكسرة محاولا أن يكون أكثر إفهاما: “نحن لا نقول لنك، هذه تسمية كارهيه التي لا نحبها، نحن نقول الأمير تيمور رحمه الله وهو قائد عظيم لم يهزم أبدا”.
أجادله قائلا: “لكل شعب روايته، ولكن أغلب الشعوب التي غزاها تيمور، وهي بالعشرات، لا تتفق معك، لكن من المهم أن نقارن تواريخ الشعوب وسردياتها المتزامنة فهذه المقارنة هي بداية المعرفة”.
عوالم تيمور الآسيوية
وفي حوارنا السابق مع المؤرخة الفرنسية ماري فافيرو، المختصة بتراث المغول، قالت للجزيرة نت إنه في النصف الثاني من القرن الـ13، تكثف التبادل الاقتصادي، وضم كل أوراسيا تقريبًا، واعتاد المؤرخون على تسمية هذه الطفرة التجارية غير المسبوقة “سلام الهيمنة المغولي” (Pax Mongolica).
وقالت فافيرو إن “التبادل المغولي، يتجاوز الفصل بين العصور الوسطى والحديثة. إنه يسد الفجوة بين طريق الحرير في العالم القديم وعصر الاستكشاف في العالم الحديث، وهو مقدمة للتبادل الكولومبي (نسبة لكريستوفر كولومبس مكتشف العالم الجديد) في أوائل القرن الـ16 الميلادي.”.
يكشف كتاب “الخانية: كيف غير المغول العالم” لفافيرو- أن إنجازات المغول امتدت إلى ما هو أبعد من الحرب. فلمدة 300 عام، لم يكن المغول أقل قوة في التنمية العالمية مما كانت عليه روما، ولم تكن الثقافة السياسية المغولية قائمة على تركيز السلطة في يد الحاكم، ولقد ترك المغول وراءهم إرثا عميقا في أوروبا وروسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، ولا يزال ملموسًا حتى يومنا هذا.
ويناقش الكتاب مزايا القوة الجماعية البدوية في الجغرافيا السياسية والتجارة، وكيف يمكن أن تولد الإمبراطوريات من شعوب ودول متحركة، وليس فقط من القوى المستقرة والإمبراطوريات الاستعمارية المرتبطة عادة بالعصر الأوروبي، ويُظهر الكتاب بشكل قاطع أن “الرعي ليس مرحلة بدائية على طريق التحديث”، ولكنه أسلوب حياة مختلف تمامًا نجحت فيه القوى المغولية عبر ديناميكيات التكيف والتجارة والدبلوماسية. كما خلص إلى أن النجاح الإمبراطوري المغولي لم يحدث على الرغم من كونهم قبائل بدوية وإنما تحديدا بسبب تلك البداوة.
ممالك البارود
كان تيمور آخر أمير حرب من سلسلة البدو العظماء الذين خرجوا من وسط آسيا لفتح العالم، ومهدت إمبراطوريته الطريق لظهور إمبراطوريات الصين والهند وروسيا، بالإضافة لممالك البارود الإسلامية الأكثر تنظيمًا والأطول عمرا، ويشير المصطلح لـ3 ممالك ذات أصول تركية وهي الدولة العثمانية والصفوية ومغول الهند من القرن الـ16إلى القرن الـ18.
ولممالك البارود الثلاث –التي امتدت من خليج البنغال وميانمار شرقا وحتى أوروبا الشرقية وشمال أفريقيا- صلة بالأمير تيمور؛ فمغول الهند ينحدرون من سلالة بابر (1483-1530) مؤسس سلطنة مغول الهند، والصفويون أنشؤوا دولتهم في أعقاب تفتت إمبراطورية تيمور لا سيما في إيران وبلاد فارس بداية القرن الـ16 الميلادي.

أما العثمانيون فقد خاضوا حروبا طويلة مع جيوش تيمور الذي بدأ نهاية عام 1399 حربه مع السلطان العثماني بايزيد الأول، وغزا بعدها القوقاز وحلب ودمشق عام 1400 وأعمل فيها القتل والنهب، ثم غزا بغداد 1401 وزحف جيشه كالنمل والجراد، كما يصف المؤرخون، وهاجم تيمورلنك الأناضول وهزم بايزيد في معركة أنقرة عام 1402 وأخذه أسيرا ليخلو العرش العثماني 12 عاما، وأعادت تلك الحروب تعريف السلطنة العثمانية لاحقا كإمبراطورية أوروبية.
من الشرق للغرب
في ذلك العالم، كانت ممالك وإمبراطوريات الشرق أقوى من نظيرتها الأوروبية التي كانت تعيش عصورها الوسطى المظلمة، فما الذي حدث لاحقا؟ هل كان عصر النهضة والهيمنة الأوروبية صعودا حتميا لحضارة متفوقة أم أن عوامل أخرى غيرت قواعد اللعبة ونقلت مراكز القوة من الشرق للغرب؟ أو بعبارة أخرى هل قرصنت أوروبا وممالكها نظاما عالميا متطورا والتقطت الثمرة بعد أن نضجت؟
حاول مؤرخون أوروبيون كثر الإجابة على هذا السؤال في كتب تواترت أفكارها، مثل “صعود وسقوط القوى العظمى” لبول كينيدي و”ثروة وفقر الأمم” لديفيد لانديز، و”إمبراطورية.. الغرب والبقية” لنيال فيرغسون.
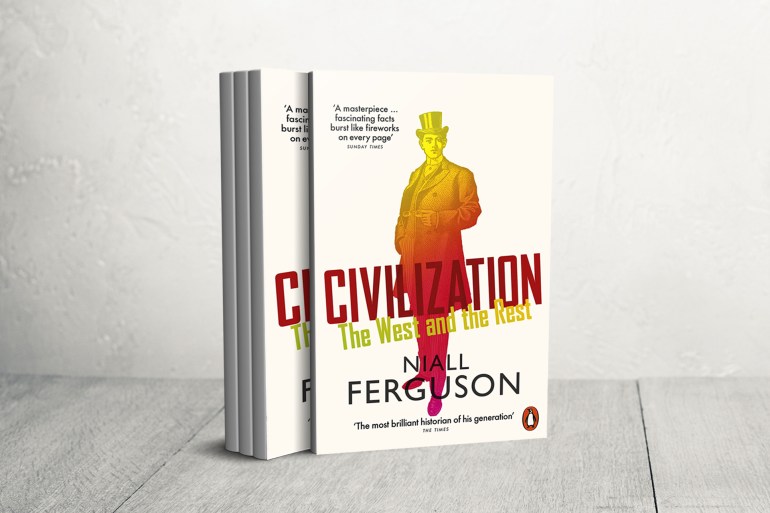
ونفى هؤلاء المؤرخون وغيرهم أن يكون صعود الغرب حتميا فلم تكن الهيمنة الأوروبية مسارا مقدرا ولا عملية خطية؛ بل كانت الممالك الأوروبية منقسمة ومتنازعة ومفتتة.
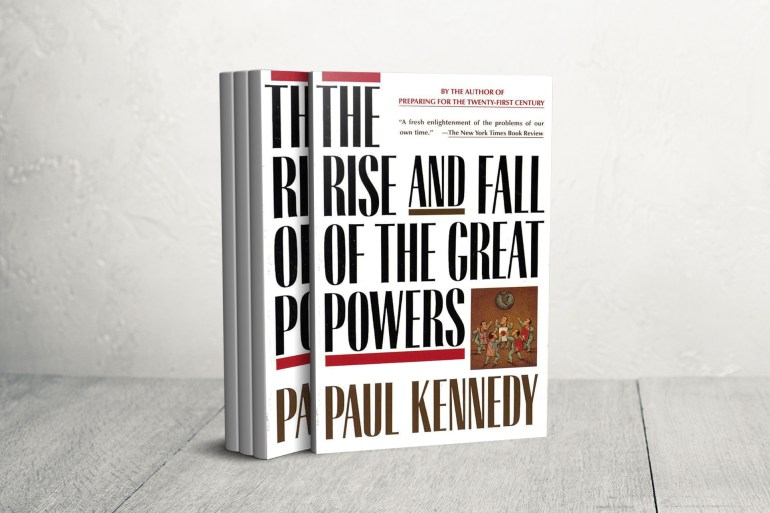
أسلحة وجراثيم وفولاذ
ويخلص المؤرخ البريطاني جون داروين في كتابه المهم “بعد تيمورلنك: التاريخ العالمي للإمبراطورية منذ عام 1405” لأننا ما زلنا نعيش في ظل تيمورلنك، فتاريخ العالم هو تاريخ إمبراطوري أو تاريخ الإمبراطوريات.
كانت أوروبا عاجزة أمام الحضارات والإمبراطوريات الهندية والصينية واليابانية والعثمانية حتى ثلاثينيات القرن الـ19. وحتى في أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث كانت المقاومة محدودة، لم يكن الأوروبيون في وضع يسمح لهم بنيل ما أرادوا دون متعاونين محليين، فما الذي تغير؟ الإجابة هي “الظروف”. وهي الإجابة التي يتفق فيها أيضا مع داروين المؤرخ الأميركي جارد دايموند صاحب كتاب “أسلحة، جراثيم وفولاذ: مصير المجتمعات البشرية”.

يرفض دايموند التفكير في أي تفوق أو أفضلية غربية في مجالات الفكر الإبداعي والأخلاق وحتى العوامل الوراثية، بالمقابل يجزم بأن الفجوة الحقيقية أو “الظروف” تعود لعوامل القوة والتكنولوجيا التي حدثت بسبب تأثير الجغرافيا على المجتمعات؛ بعبارة أخرى الحضارة الحديثة لم تكن نتيجة ذكاء وإبداع وإنما كتطور لشروط مسبقة جعلتها ممكنة.
وعلى خطى دايموند، دوَّن جون داروين قرابة 600 صفحة من تأريخه للعصر الحديث، رافضا حجج التفوق الثقافي الأوروبي، ويستنتج في النهاية أن الألفية القادمة قد تكون -كما كانت- صينية أو إسلامية وربما مزيجا من الاثنين معا، لكنها بالتأكيد -وفق المؤرخ البريطاني- لن تكون مبنية على الهيمنة الأوروبية.
ويرى داروين أن مركز الثقل الحقيقي لتاريخ العالم كان يقع في منطقة أوراسيا (أو سهوب آسيا الوسطى)؛ مشيرا إلى أن “الإمبريالية الغربية الصاعدة” كانت أمرا هامشيا على متن الإمبراطوريات الآسيوية الشاسعة والثرية والديناميكية سواء في الصين والهند المغولية أو الشرق الأوسط العثماني وإيران الصفوية وغيرها من البلاد التي قاومت التمدد الغربي لقرون.
فبالتزامن مع نجاح الإمبراطورية العثمانية في تثبيت استقرار حدودها؛ كانت سلالة حكام الصين تصل إلى آفاق جديدة من القوة والهيبة والازدهار، وحتى اليابان الانعزالية كانت تزدهر ويتطور اقتصادها الداخلي، بينما ابتليت أوروبا بالحروب الدينية وصراع العروش بين ملوكها، لكن كل ذلك تغير عندما أشعل الاقتصاد البريطاني شرارة الثورة الصناعية.
كذلك، لم يكن تمدد الإمبراطوريات الاستعمارية الأوروبية، وكذلك توسع الاستيطان الأوروبي عبر أميركا الشمالية والتمدد الروسي عبر سيبيريا، حتمية تاريخية، بل كانت مشروعًا بطيئًا ومتقطعًا وهامشيًّا في كثير من الأحيان، ولم يتسارع حتى منتصف القرن الـ19.
وإذ يحلل داروين المزايا التكنولوجية والتنظيمية والاقتصادية التي اكتسبها الأوروبيون بمرور الوقت، فهو كذلك يوضح مدى اعتماد نجاحهم على تقلبات التجارة العالمية (القوة الدافعة للإمبريالية الحديثة، في نظره) والتأثير في السياسات الداخلية للبلدان التي سعوا للسيطرة عليها.
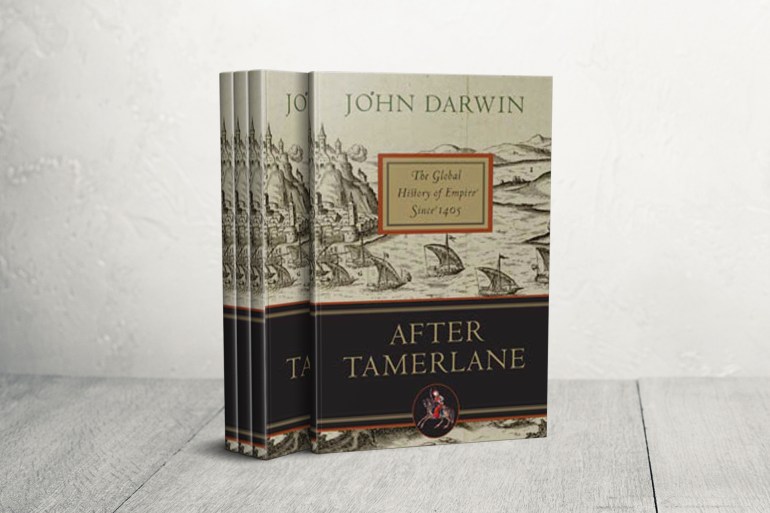
سردية صعود الغرب
ويتحدى كتاب “بعد تيمور لنك” السرد التقليدي لـ”صعود الغرب”، موضحًا أن الهيمنة الأوروبية لم تكن مسارا “مقدَّرًا” ولم تكن عملية خطية؛ فالمحيطات التي توسعت فيها أوروبا في عصر النهضة كانت فقيرة مقارنة بثراء بلاد فارس وآسيا الوسطى والصين والعالم التركي.
وإذْ أدت الحملات الإسبانية والبرتغالية إلى إنشاء “جيوب محدودة” تقع على أطراف آسيا، أو ساحل أفريقيا، أو سواحل أميركا؛ فقد افتقد الغزاة إلى القوة الساحقة اللازمة لشق طريقهم إلى الداخل، لكن الجراثيم أدخلت مجموعة صغيرة من الغزاة إلى المكسيك الأزتيكية بعد أن شن الجدري والحصبة حربهما لجانب الأوربيين. ولم يكن بوسع أوروبا أن تفعل الكثير لفرض ثقافتها وشروطها التجارية على الأنظمة السياسية الآسيوية الأكبر حجمًا في مرحلة ما قبل الصناعة الحديثة، ولم يكن هناك شيء من صنع أوروبا تريده آسيا. لكن كان التصنيع الحديث هو العامل الذي غير لاحقا قواعد اللعبة.
ومع ذلك بينما يفترض المؤلف وجود “العديد من الحداثات المختلفة”، يبدو ذلك بمثابة عزاء للعديد من البلدان ومناطق العالم الخاسرة التي افتقرت إلى التكنولوجيا اللازمة لصد الغزاة الغربيين، كما يفيد الكتاب.
لكنَّ قراءة داروين للتاريخ تخلص إلى أنَّ الدائرة ستدور من جديد، وهذا أمر ينبغي التفكير فيه في عالم ما بعد الحرب الباردة؛ حيث ترفع العديد من الدول التي اختنقت ذات يوم في عالم ثنائيِّ أو أحاديِّ القطبية صوتها مرة أخرى، في حين تفقد أوروبا أهميتها، وتكتشف الولايات المتحدة أنها لم تعد بالضرورة “الأمة التي لا غنى عنها”.









