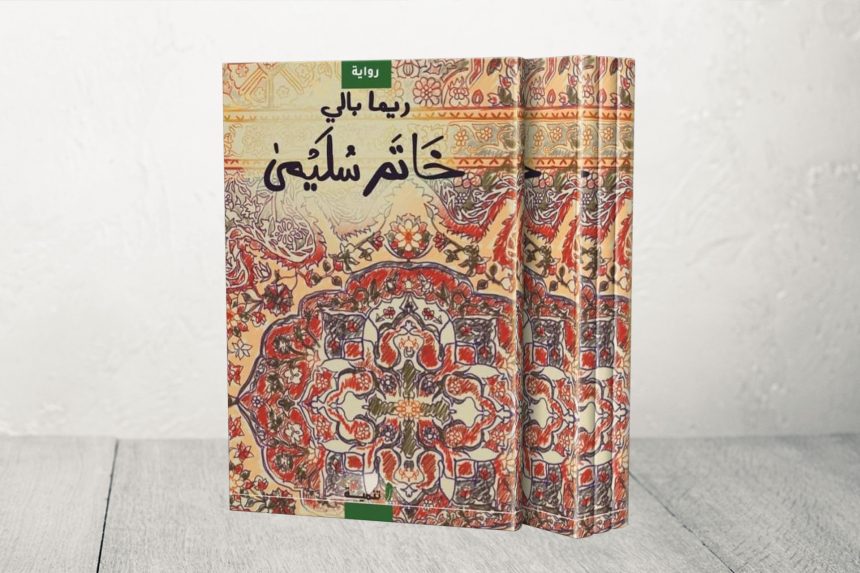في روايتها الرابعة “خاتم سليمى، التي صدرت طبعتها الثانية عن دار تنمية المصرية في عام 2024، تكتب الكاتبة السورية، المقيمة في مدريد منذ عام 2015، ريما بالي بطريقتين مختلفتين، رغم أنه من الصعب قطع الشعرة بين هاتين الطريقتين. فهي من جهة تروي حكاية سليمى وحكاية مدينة حلب السورية خلال فترة، أو فترات زمنية مختلفة، جامعة أشياء مكانية وروحية وشخصية تميز مدينة حلب عن غيرها من المدن، وفي الوقت نفسها قد تقربها، تلك الميزات من مدن أخرى في قارة أخرى، ولكن هذه الحكاية ستكون فضاء للحكاية الأساسية الأخرى.
وترشحت الرواية للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية التي تضم 6 روايات من المقرر اختيار واحدة منها في 28 أبريل/نيسان الجاري لنيل الجائزة البالغ قيمتها 50 ألف دولار.
ومن جهة أخرى، تقوم ريم بالي (ولدت في عام 1969) بتأليف حكاية حب، بل حكايات حب، ضمن هذه الحكاية الأولى، ولشخصيات تنتمي إلى أماكن خارج حلب، لكي تقوم بشرح وتفكيك حلب، وكذلك لشرح وتفكيك مدينة أخرى تشبه حلب بطريقة أو بأخرى. وهذا بالذات يطرح سؤالا جوهريا: هل يتشابه الناس روحيا وذوقيا وأخلاقيا وفنيا لو كانوا من مدن متشابهة؟ وما تأثير تلك المدن على مصائر الناس؟
الخاتم ودلالاته
عند ذكر خاتم ما، قوي ومختلف وذي سلطة، لا بد أن يذهب ذهن أحدنا إلى “خاتم سليمان”، فهو الذي منحه الله لسليمان لكي يستطيع السيطرة على البر والبحر والرياح ومخلوقاتها. وشهيرة هي قصة غنى وقوة النبي سليمان مع خاتمه، وعوزه وفقره وضعفه من دونه، ثم استعادة قوته من خلال استعادة الخاتم. وريم بالي منحت عنوان رواياتها ذلك النحت اللغوي من تلك القصة، فالشخصية الأنثوية الأساسية “سليمى” هي التي تعرف قوة ذلك الخاتم وتلك الحكاية، وتؤمن بكلا الأمرين، لذلك تصنع خاتمين متشابهين لكي تحقق نبوءة في زمن خلا من تلك النبوءات.
وهذا ما جعل مفتتح الرواية يكون مع عثور أحد البطلين الذكرين الرئيسيين في العمل على خاتم سليمى في الحمامات الخاصة بالرجال في بيروت. ونكتشف في نهايات الرواية من الذي ترك له الخاتم هناك عمدا، لكي تتحقق نبوءة سليمى مع العاشق الأصغر سنا، بعد أن أخفقت مع المعشوق الأكبر سنا.
تستفيد ريم بالي من سحر حلب، وخاصة حلب القديمة، ببيوتها وبلاطاتها وأسواقها وتراثها وروائحها وأكلاتها، بينما يكون أناسها أصحاب حظ كبير في الانتماء لذلك المكان. وحتى الغرباء الذين يأتون إليها، مثل الموسيقي الإيطالي سيلفيو أو المصور الإسباني لوكاس، يغرقون فيها وينتمون لها في النهاية، غير قادرين بسهولة على الفكاك من ذلك السحر.
ولكن بالي تقدم حلب في زمن حديث، رغم عودتها الاضطرارية للزمن القديم وتراثيته، مازال محافظا على ذلك السحر الذي تنشره حلب في دواخل حياة الناس. وعندما تحصل الثورة، أو الحرب الأهلية أو الأحداث، في سوريا ضد نظام الأسد (في ربيع عام 2011)، وتصل تلك الثورة إلى حلب، يتهدم كل ذلك السحر لتلك المدينة، وتطفو وحشية الناس، المقيمين أو الغرباء المجاهدين، على كل ذلك السحر الذي ينطفئ، سوى في دواخل الناس الخائفين والعاشقين، لتنير القسوة والوحشية المكان.
ولأن بالي تذكر أسماء حقيقية لأشخاص عاشوا وقتلوا خلال تلك الأحداث المستمرة، مثل الصحفية الأميركية ماري كولفن والمصور الفرنسي ريمي أوشليك اللذين قتلا في مدينة حمص في فبراير/شباط 2013، خلال قصف لقوات النظام السوري عليها، سيظن أحدنا أن كل ما هو في الرواية حقيقي وغير متخيل. ولكن هناك جزء جيد من الرواية متخيل، رغم أنه يبدو أقرب إلى الحقيقي، وهي ميزة إيجابية تحسب للرواية في إيهام القارئ بأن ما بين يديه سيرة لشخصيات وأمكنة وعلاقات حقيقية.
فن وفكر وآراء
ولأن الرواية قد تبدو لبعضهم بهذا المعنى، فقد يصدق الرأي الذي فيها بأن “مفاجآت كثيرة تكشفت في تلك الفترة، إذ تبين أن كثيرا ممن كانوا طوال السنوات السابقة يتذمرون علنا من النظام وطريقة حكمه للبلاد، هم من أشد الموالين له في لحظاته الحرجة، تناغما مع مصالحهم التي قد تدمرها فوضى التغيير إن حصلت، وبالمقابل تبين أن كثيرا من الصامتين الخانعين أو المواطنين الصالحين خلال عشرات السنوات السابقة، هم من أشد المعارضين والراغبين بخلع النظام عن كرسي الحكم. كان لكل طرف أسبابه، ولم تكن كل الأسباب نزيهة، إذ كان الكثيرون يعارضون أو يوالون النظام انطلاقا من أسباب طائفية بحتة، أو مصالح اقتصادية” (الصفحة 184-185) وهو رأي فيه تعميم قد يجافي الواقع، خاصة أنه رأي لم يأت في حوار بين شخصيتين، بل يقوله الراوي العالم.
وشيء آخر، يتعلق بهذا الرأي، تكرسه ريما بتحول عازف ومنشد في فرقة سيلفيو الإيطالي عاشق حلب ومعشوق سليمى، إلى مقاتلين طائفيين ضد بعضهما البعض، وهذا ربما يحتاج لنقاش كبير.
وبهذا المعنى تمرر ريما بالي رأيها من خلال الراوي العالم، الذي لا يبقى راويا وحيدا في العمل، بل يتبدل، ولو بشكل قليل، بين عدة شخصيات، مثل سليمى ولوكاس.
وريما بالي تستخدم في كتابتها تقنيات متعددة في السرد في بناء حكايتها هذه، مثل الحوار وكتابة الأحلام وكتابة المذكرات والاستفادة من كتاب “مثنوي” لجلال الدين الرومي، وتاريخ الأمكنة.
ومن خلال تقنية تفكيك المكان، استطاعت ريما أن تأخذ القارئ في رحلات إلى مدينة توليدو الإسبانية، حيث يعيش عاشق حلب وعاشق سليمى، المصور لوكاس، وأن تقوم بتقريب المكانين الرئيسين من بعضهما البعض، في تحليل داخلي لشخصية لوكاس نفسه. حتى يتفق الطرفان على أنه “ما أشبه حلب بتوليدو” (الصفحة 98). وهذه مصادفة غريبة، حيث إن حلب أدرجت في قائمة لليونيسكو لمواقع التراث العالمي في عام 1986، وهو العام نفسه الذي أدرجت فيه توليدو في القائمة ذاتها.
تقدم صاحبة رواية “ميلاجرو” (2016) حلب وناسها بطريقة لافتة، معتنية بالتفاصيل والأحداث والتواريخ، مقدمة العديد من الشخصيات المؤثرة والمنتمية لطبقات فكرية واجتماعية واقتصادية مختلفة، بينما اكتفت بالنسبة لشخصية لوكاس بتقديم زوجته وابنه وعائلاتهم، في قصص وحكايات مثيرة، من خلال اختلاف الدين أو الآراء.
ولوكاس هو إحدى الشخصيتين الذكوريتين الأساسيتين في الرواية. فسيلفيو الإيطالي الذي أسلم وسمى نفسه شمس الدين، أكبر من سليمى بكثير، وهي عشقته ولم تعد تعرف، وكذلك لم تعد تريد، كيف تتخلص من هذا العشق. عشقته لأنه “يعرف كل شيء”.
بينما لوكاس، المصور الإسباني الشهير والمتزوج، وقع في حبها، وعاش تجربة الشموع والسجادة السحرية الغريبة، ولكنه بالنسبة لها، وللأخريات في حياته، “لا يعرف أي شيء”. أحدهما يعرف كيف يتجنب الانسحاق تحت عجلات الحب، والآخر يغرق فيه، ولو من دون رغبة، بسبب طيبته وخجله، “فهو (أي لوكاس) في كل مرة ومع كل النساء اللاتي مررن في حياته، لا يعرف كيف يوجه دفة العلاقة، ولا يعرف كيف ينهيها حين يشعر في الرغبة في ذلك، فقد تعود أن يتجاهل رغباته خوفا من دموع النساء وخشية إيلامهن” (ص 230)، وربما خجل لوكاس هو السبب الأساسي الذي دفعه ليختار مهنة التصوير الفوتوغرافي ويترك كلية الحقوق، لكي يختبئ خلف الكاميرا، أو لأن الكاميرا تستطيع أن تخفي دواخله عن الآخرين.
زمن الخط الرئيسي للرواية هو تقريبا 20 عاما، ولكن صاحبة رواية “غدي الأزرق” (2018) تأخذ القارئ في رحلات زمنية مختلفة، لتتبع تاريخ عائلات الشخصيات ومدنها، وبالتالي يصبح الزمن فضفاضا في هذا العمل. وبسبب ذلك تتجول الرواية كذلك في أماكن مختلفة مثل حلب وبيروت وفرنسا وإيطاليا وتوليدو ومدريد وسانتاندير.
وفقت صاحبة رواية “ناي” في بناء الشخصيات الأنثوية والرجالية، وفي الحوارات فيما بينها، وتركت الشخصيات، في أغلب الأحيان، تذهب مرتاحة إلى مصائرها المختلفة، وأضفت عليها الكثير من العاطفة التي لم تفلت من بين يديها، فحولت روايتها “خاتم سليمى”، التي تجري في 304 صفحات، والتي قد تبدو خاتمتها غريبة وغير مفهومة وقد تنسف كل شيء، إلى قصص حب واقعية وخيالية يتلبسها عشق المكان وسحره الغريب، وكذلك عنفه.