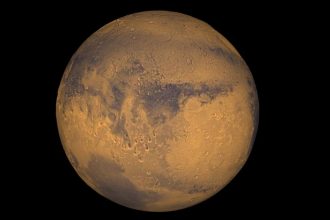يوثق الفيلم الأميركي ” القاتل” (The Killer) للمخرج ديفد فينشر، لحالة من حالات “الخرس” و”انقطاع التواصل” في العالم إلا من خلال الرصاص والدم. فرغم بلوغ مدة عرضه نحو الساعتين فإن الحوار في الفيلم لا يتجاوز بضع جمل، بينما منح القاتل فرصته الكاملة في سرد القصة برؤيته الخاصة عبر استخدام التعليق الصوتي.
والفيلم هو الـ95 في مسيرة مخرجه، وهو من بطولة مايكل فاسبندر الذي جسد شخصية قاتل محترف، يُعد الالتزامُ بقواعد المهنة أبرز صفاته، فلا مشاعر ولا أخلاق ولا ندم يمكن أن يثنيه عن مهمته التي يتقاضى الأجر عليها، لكنه ينحدر نحو فقدان الكفاءة التدريجي بسبب أوقات انتظار اللحظة المناسبة التي يستطيع خلالها أن يطلق النار على ضحاياه، ويحدث بالفعل أن يخطئ هدفه فيتحول إلى هدف مطلوب التخلص منه، وتبدأ معركة دموية بينه وبين شركائه السابقين.
ويعد إطلاق فيلم جديد لديفد فينشر مناسبة سينمائية تستحق الاحتفاء، لكن الفيلم الجديد لم يحقق الإيرادات المتوقعة، رغم أن تاريخ فينشر مع صناعة الأفلام قد تَشكل عبر نجاحات اعترف بها الجمهور والنقاد على اختلاف انتماءاتهم السينمائية. ومن بين أفلامه التي حققت نجاحات كبرى “حالة بنجامين بوتون العجيبة” 2008 (The Curious Case of Benjamin Button)، و”الشبكة الاجتماعية” 2010 (The Social Network)، و”سبعة” Seven) 1995)، و”نادي القتال” Fight Club)1999)، و”زودياك” Zodiac) 2007)، و”الفتاة ذات وشم التنين”2011 (The Girl with the Dragon Tattoo).
وكان فيلم “القاتل” عُرض في الدورة الـ80 من مهرجان فينيسيا في الثالث من سبتمبر/أيلول الماضي، ثم انطلقت عروضه التجارية في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي في دور العرض، وأخيرا بدأ عرضه على شاشة منصة نتفليكس في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
عودة الفيلم المظلم
يحمل فيلم “القاتل” ملامح سينما فينشر، بدءا من الأجواء المقبضة التي تفيض بها أغلب أعماله الأخيرة إلى تناول سيرة القتلة، مع ذلك الشغف الذي يصل إلى حد الهوس بالتفاصيل الدقيقة للأشياء. لكن جرعة “العتمة” التي تسوق بالضرورة إلى أجواء مخيفة ومربكة وأحيانا مسببة للاكتئاب، زادت في هذا العمل الذي جمع أغلب سوآت المجتمع الغربي وبينها العزلة والعدوانية وتقنين كل تفاصيل الحياة وصنع قواعد لها، مما جعل القاتل أو “مايكل فاسبندر” يبدو وكأنه روبوت بسبب انتظام حركته وعدم وجود ابتسامة واحدة على وجهه طوال ساعتين من الدراما الفردية.
ويعود فينشر في فيلمه الجديد بالزمن أكثر من 80 عاما إلى الوراء ليعيد إحياء نوع معين من الأفلام ظهر في أربعينيات القرن الماضي وأطلق عليه “فيلم نوار” (Film Noir)، وهو نوع أميركي نموذجي في الولايات المتحدة. ووفقًا للمؤرخ السينمائي باتريك بريون، فإن هناك “مصائر مأساوية لا يمكن التغلب عليها تسحق شخصياته وتتمثل في النهاية التراجيدية”.
ويقدم فينشر “فيلم نوار جديدا” (Neo Noir)، حيث يضيف إلى قيم فيلم نوار الفرنسي الأميركي لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية سمة حديثة تتعلق بعالم القرن الـ21 وقضاياه الاجتماعية والتحولات القاسية التي طرأت على الأسرة والأجيال الجديدة، وهو ما بدا واضحا في فيلمه “الفتاة ذات وشم التنين”.
الصوت والضوء
وبين صوت هادئ لكنه حاسم ومخيف، وضوء يهدف للإخفاء أكثر مما يهدف للظهور، يكشف القاتل الذي لا يحمل اسما عن شخصيته وعن صفاته والقوانين التي يحاول بها السيطرة على عالمه، لكن كل مشاهده -تقريبا- جاءت داخلية معتمة، وحتى تلك الخارجية وضع فينشر ومدير تصويره كشافات الإضاءة الخافتة نسبيا بمواجهة “فاسبندر” فبدا مظلما، وهو ما يعكس رؤية المخرج لذلك القاتل الذي يحمل كل ظلام العالم في داخله، ويتحرك كخفاش في المساحات المظلمة من الشوارع، ولا يترك المكان الذي تطؤه قدماه إلا وهو يحمل جثة أو يترك أخرى.
كان فاسبندر رابضا خلف سلاحه في المشهد الأول للعمل، يقبع في مكان مظلم من غرفة بمواجهة هدفه الظاهر عبر النافذة في المبنى المقابل، وبينما يسبح الضحية في أضواء باهرة، يطل الخفاش القاتل من ظلمته عبر عدسة السلاح بعينيه، وينتظر الحركة المناسبة لضحيته التالية، وحين أخطأ أدرك السيناريو القادم، فهي مهنة لا يُسمح فيها بهامش خطأ مطلقا، لذلك سارع بالعودة إلى بيته المعزول أيضا عن العالم، فوجد رفيقته في المستشفى بعد تعرضها لاعتداء وحشى، وهنا بدأ مشوار الانتقام وتصفية شركائه السابقين.
وإذا كانت وظيفة الإضاءة في السينما هي توضيح الأشياء لرؤيتها في المقام الأول، فإن تلك الإضاءة التي تفقد وظيفتها عبر وضع مصادرها في أماكن تهدف للإخفاء، إنما تنقل المشاهد إلى منطقة عدم الراحة، لكنها تشكل مشاعر متضاربة بين التشويق وانتظار زوال الظلمة، وتوقع المزيد من الدراما.
اهتم فينشر بالقصة فيما سبق من أفلام وشكل من تفاصيلها الدرامية لوحات سينمائية نابضة بالحياة، خاصة مع البناء المتقن لشخصيات أعماله التي يفضل اقتباسها من روايات أدبية. لكن الإضاءة والتعليق الصوتي الذي لم يسرد بقدر ما قام بالوصف؛ صنعا حالة مختلفة عن الأفلام السابقة للمخرج، فقد وضعت المشاهد “على وضع الانتظار” طوال العمل، وكأن صانع العمل لم يجرؤ على السير قدما نحو ذروة درامية.
وباستثناء دقائق قليلة تتوسطه، خلا الفيلم من الحوار، واكتفى بالسرد الذي بدا متعاليا على المشاهد، إذ قدم خلاصات تحكي عن قواعد مهنة القتل، وضرورة الالتزام بقواعد عدم الثقة وعدم التعاطف والالتزام بالخطة المتفق عليها وما شابه.
والخلو من الحوار في العمل مبرر تماما، حيث يتحدث العمل لغة الرصاص والسكاكين وشتى طرق القتل، وبدا الفيلم كأنه “مونودراما” نقلت من المسرح إلى السينما. أما الاستثناء فجاء في سياق عثور القاتل على امرأة شاركت في الاعتداء على رفيقته، والمناورات التي قامت بها لخداعه ثم قتله لها. وللمرة الثانية يتجاهل صناع العمل فكرة تسمية البشر، فاكتفوا بوصفها باعتبارها امرأة تشبه أعواد تنظيف الأذن نظرا لنحافتها الظاهرة، وجسدت دورها الممثلة ذات الأصل الأسكتلندي تيلدا سوينتون.
الظلام الحقيقي
يكمن خلف كل تلك العتمة التي أخفى بها ديفد فينشر ما يقرب من نصف تفاصيل عالمه على الشاشة سؤال قاس عن التحولات التي مرت بها الإنسانية في القرنين الماضيين على الأقل، فالعالم الذي حرص على إظهاره هو عالم كئيب موحش متوحش يقتل لئلا يقتل، فهل تحول كل شخص على الكرة الأرضية إلى قاتل محترف عليه أن يتربص في عتمة الظلام بضحيته ويقتله، فمن سينجو إذا بحياته وحياة أسرته؟
أسئلة قادمة من عقل رجل اعتاد على استخدام جريمة قتل واحدة -على الأقل- في كل فيلم من أفلامه للتفتيش في حاضر وتاريخ شريحة مجتمعية مختلفة، ومن ثم إلقاء ضوء كاشف ومبهر على حقيقة غابت لسنوات تطول أو تقصر.
لكنه قرر أخيرا عدم الكشف عن النصف المضيء من العالم إلا في مشهد النهاية، إذ قُتل الشركاء القتلة، وانضم القاتل (مايكل فاسبندر) إلى رفيقته على الشاطئ بعد شفائها لتستمر الحياة.