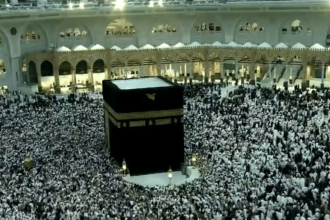لفتني ما قرأته في إحدى الدراسات -التي أجرتها جامعة ستانفورد في كاليفورنيا- عن أن المتحدثين بالإنجليزية يركزون أثناء قص الحكاية على الأسباب، بينما يركز المتحدثون باليابانية والإسبانية على الحدث نفسه بدون العناية بذكر الفاعل أو المسبب. وهذا يعكس أسلوبهم العام في التفكير والنظر إلى الأمور والأحداث، وتربط الدراسة هذا الاختلاف بتأثير منطق اللغة على المتحدثين بها، فلكل لغة منطقها ومنهجها التفكيري.
جدلية العلاقة بين اللغة والفكر والتفكير
بين اللغة والتفكير علاقة جدلية شغلت المهتمين والباحثين والفلاسفة واللغويين فانقسموا وتحاجوا، وقد برز في هذا الموضوع فريقان، الأول يقول بانفصال الفكر عن اللغة وعجز اللغة عن الإحاطة بأفكار الإنسان، وفريق يقول باتصالهما لأن اللغة أداة التفكير ووسيلتنا إليه.
ويمثل ديكارت وفاليري وغيرهما الفريق الأول، إذ يذهبون إلى أن تفكير الإنسان لا يهدأ ولا يتوقف في حين يمكن له أن يتحكم بلغته ونطقه وحديثه. ويعبر برغسون عن هذا المعنى بقوله “الفكر ذاتي فردي، واللغة موضوعية واجتماعية”.
كما يرون أن اللغة قالب التفكير، وكثيرا ما يعجز الناس عن التعبير عن أفكارهم باللغة، وحجتهم في ذلك توقف المرء أثناء الحديث أو الكتابة عن موضوع ما باحثا عن ألفاظ تعبر عن مراده وتفي بغرضه منه.
ويذهب الفيلسوف الألماني كارل ياسبرس إلى أن “اللغة تجبر الفرد على أن يسلك طريق واحدا فينتج عن ذلك أن يبدو أفراد المجتمع الواحد وكأنهم يفكرون بالطريقة نفسها”.
وعبر برغسون عن ذلك بقوله “الألفاظ قبور المعاني” في حين يقول هاملتون “الألفاظ حصون المعاني”. يذهب أصحاب هذا الرأي القائل بعجز اللغة عن الإحاطة بالأفكار وقصورها عن الوفاء بالتعبير عن المشاعر، إلى تأكيد فكرتهم وتدعيمها بلجوء الإنسان إلى الفنون المختلفة كالموسيقى والرسم لتدارك ما عجزت اللغة عن التعبير عنه. لكن السؤال الأعمق هنا هو: هل عجزت اللغة فعلا أم عجز الناس عن الإحاطة بكنوز اللغة ألفاظا ومعاني للتعبير عما يفكرون به ويشعرون به؟ أليست اللغة محض أداة للتعبير والتواصل؟ فلماذا نلصق العجز بها؟
أما الفريق الثاني أمثال هيغل وسوسير فيذهبون إلى القول بسير اللغة مع التفكير نظرا إلى أنهما أمران مكتسبان من العائلة والبيئة المحيطة بفعل التجارب والأحداث المعيشة منذ سنوات الطفولة المبكرة، فحين يتعلم الطفل لفظا جديدا يربطه بمعناه عقليا، ويهيئ نفسه لاستعماله وتكراره في الموقف المناسب، وبذلك تسير اللغة جنبا إلى جنب مع التفكير، بل تسبقه لفظا إلى عقل الطفل أثناء مراحل التعلم والتعرف إلى الألفاظ والمفاهيم بوصفها الدال والمدلول.
وفي ذلك يقول هيغل “الكلمة تمنح للفكرة وجودها الحقيقي والأسمى”. ويقول واطسون “إننا نفكر بلغتنا، ونتكلم بفكرنا” لذا يبدو من الغريب بمكان أن تعجز اللغة عن التعبير عن الأفكار ما دامت وعاءها والفم الناطق بها في أذهاننا ونجوانا بيننا وبين أنفسنا بالدرجة الأولى. وإن حدث وشعر المرء بالعجز عن التعبير عن فكرة ما في ذهنه فإن في ذلك دليلا على أن الفكرة ما تزال ضبابية وغائمة في نفسه.
ويرى عبد السلام المسدي أنه “ليس من معرفة إلا وهي مستقاة عبر مصفاة اللغة” فاللغة انتقاء واصطفاء وترتيب وعرض للأفكار. ومن هنا جاءت فكرة هيمنة التداول اللغوي على الفكر الإنساني، فالغلبة للمفردات والألفاظ الأكثر شيوعا واستعمالا، للتفكير والتعبير بها عن الأفكار مهما كانت بسيطة أو عميقة.
الثراء اللغوي في ثراء الفكر والعقل
بناء على الاستعراض المعلوماتي آنف الذكر فإنه يمكننا القول: إن للغة مستويات خطابية مختلفة، فهي تخاطب العقل مقروءة، وتخاطب العقل وحاسة السمع والبصر منطوقة، ومن هنا ندلف إلى حديث الأسلوب، فتعابير المتكلم وإفاداته اللغوية وأسلوبه التعبيري يرفد ما ينطق به ويدعمه إيجابا أو ينحو به منحى سلبيا. وتعد تلك اللغة التي تخاطب العقل والحواس رمزية، وهي منحازة بلا شك وأبلغ تأثيرا من سواها المجردة من أي ظروف أو روافد، وذلك لأنها أسرع في النفاذ إلى العقل الباطن للمخاطب.
واللغة في حقيقتها قالب التفكير وأداته، والسؤال عن الأسبقية بينهما يشبه السؤال عن أولية البيضة والدجاجة! فهل فكر الإنسان قبل أن ينطق أم أنه نطق ثم فكر؟ وما جدوى معرفتنا لذلك؟
وترتبط اللغة بما فيها من رموز وتعابير بأنماط التفكير السائدة في المجتمع، ومن هنا نذكر حرص العرب وتعارفهم على إرسال أبنائهم فلذات أكبادهم إلى البادية وتحمل صعوبة الموقف والصبر عليه، ليكتسب الأطفال اللغة العربية الفصيحة الصريحة من الأقحاح، والتي لا يشوبها شائب أو عارض من عوارض الاختلاط بالأمم الأخرى، لا سيما في سنوات الطفولة المبكرة التي يكتسب فيها الطفل اللغة التي سيخاطب بها نفسه ومحيطه ومجتمعه. فقد جاء في كتب السير أنه كان يدفعهم لذلك “ما في هواء البادية من الصفاء، وما في أخلاقها من السلامة والاعتدال، والبعد عن مفاسد المدنية، ولأن لغة البادية سليمة أصيلة”.
وفي هذا دلالة مهمة على أن من يتقن لغة معينة فإنه يتقن معها منطق أهلها ويكتسب الأنماط التفكيرية السائدة بينهم في مقاربته للأمور ومحاكمته للقضايا، ولذا فإن من يتقن أكثر من لغة فقد حمل في نفسه أكثر من عقل وأكثر من منهجية تفكير وفقا لعدد اللغات التي يتقنها. ويقال “لغة جديدة تعني إنسانا جديدا” فإتقان اللغات يعني إتقان منطقها ومنهجها التفكيري، وتعدد اللغات المتقنة يقتضي بالضرورة توسع المدارك وسعة الأفق والقدرة على التعامل مع المسائل المختلفة بطرق تفكيرية أرحب وأشمل.
وما دامت اللغة هي الوسيلة الأرقى والأسمى للتعبير عن أفكار الإنسان وتوفير صلاته الاجتماعية مع محيطه وبيئته، فإن قدراته الكلامية وثراءه اللغوي وسلامة أسلوبه ومواءمته لمقتضى الحال تؤثر تأثيرا حقيقيا في غزارة فكره ورجاحة محاكماته وموازنته للأمور والمسائل من حوله، وتمثل رفدا أساسيا لسعة الفكر واتساع الأفق والاعتدال والاتزان والإنصاف في موازنة الأمور وتبيانها ومعالجتها، والعكس صحيح.
يقول تشومسكي “إن اللغة مؤشر على الذكاء، وهي مرآة العقل ووسيلة للتعبير عن المعاني والمشاعر والتفاهم مع الآخرين”. ويؤكد هارلوك أن النمو اللغوي عند الأطفال يعد أحد المظاهر الأساسية التي يعتمد عليها إلى حد بعيد عند قياس النمو العقلي والانفعالي والنفسي والاجتماعي للطفل، فمستوى إتقان اللغة يدل على درجة النضج العقلي.
أما سلاسة الأسلوب اللغوي ورصانته فهي خير برهان على رجاحة العقل وقدرة المرء على ترتيب أفكاره وتهذيبها ونظمها، لتقديمها بحلة قريبة المأخذ بعيدة الأثر عميقة المعنى، فالشعر العربي حين سمى ديوان العرب وسجلهم على مر العصور لم يقصد به فن الشعر بوصفه صنعة لغوية وملكة فطرية بيانية فحسب، ولم يقصد به ما حفظه لنا من أخبار ووقائع وأيام فحسب، بل هو سجل الأفكار الذي توارثته الأجيال بقالب لغوي فني بديع، فالفكر يصنع اللغة واللغة ترفد الفكر.
يقول ماكس مولر “إن اللغة والفكر كقطعة نقدية واحدة وجهها الأول هو الفكر ووجهها الثاني اللغة، فإذا فسد أي وجه من الوجهين فسدت القطعة، فالفكر بالنسبة للغة كالروح للجسد” وعن إتقان العربية يقال “من صح لسانه بالعربية صح عقله”.
شبهة حداثية
يذهب محمد عابد الجابري في كتابه “تكوين العقل العربي) إلى أن الإنسان العربي يعاني من أزمة لغوية تتمثل بكونه يحيا في عالمين لغويين مختلفين، عالم اللغة العامية الدارجة في الشوارع والمستعملة بالحياة اليومية، وعالم العربية الفصحى. فالأولى لغة ثرية مليئة بالمصطلحات والكلمات الدخيلة والمعربة للتعبير عن شؤون الحياة الطارئة والمعاصرة، لكنها لا تصلح لغة للفكر والثقافة، على عكس الفصحى التي تعد لغة الفكر واللغة الرسمية الراقية، لكنها مع ذلك تقصر عن التعبير عن كثير من مناحي الحياة الواقعية.
والحق أن في قوله مبالغة بعيدة، إذ يرى أننا لو استعملنا الفصحى للتعبير عن أفكارنا في الحياة اليومية بوصفها لغة متداولة لسكتنا عن كثير لعدم قدرتنا على التعبير بها. غير أن الأمر لا يعالج بهذه الطريقة ولا بهذه الرؤى القاصرة، فلو اعتدنا استعمال الفصحى في حياتنا اليومية لدرجت على ألسنتنا كثير من الألفاظ المهملة والمتروكة، بفعل الاستسهال والميول إلى الرائج والمعروف والمتعارف عليه بين الناس في لغة الشارع إذا جاز لنا التعبير، فالمرء حصيلة فكره ولغته، إذا ما ازدادت عنايته بأحدهما ظهر نتاج ذلك في الآخر، فغذاء الفكر يبدو واضجا جليا في سلامة اللغة ورقيها.
أما عن قدرة العامية الدارجة على الوفاء بالتعبير عن حاجات الإنسان اليومية فأساسه الاعتياد والاستسهال والركون إلى المتداول المألوف، وهي انعكاس محض لتربية المرء وبيئته الاجتماعية. وفي حين تجعل الفصحى المثقفين في ركن لغوي راق، تميل العامية إلى الانحدار بالمرء إلى البيئة الشعبية التي نشأ فيها.
وخلاصة القول: من أراد العناية بفكره وتنمية عقله، فعليه الاعتناء بلغته، ومن أراد توسيع مداركه وإثراء فكره، فعليه أن يفكر باكتساب لغات جديدة وإتقانها ما استطاع إلى ذلك سبيلا.