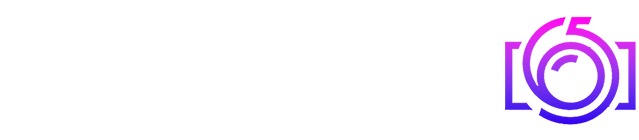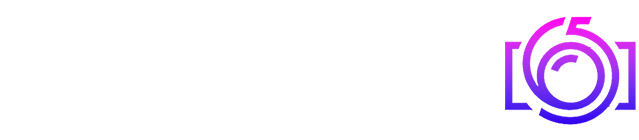القاهرة- في إطار الفعاليات الثقافية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، استضاف المعرض ندوة فكرية بعنوان “العرب والغرب: رؤى متبادلة”، جمعت بين اثنين من أبرز المفكرين العرب، هما الدكتور عبدالإله بلقزيز، أستاذ الفلسفة بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، والدكتور محمد المعزوز، الأستاذ بجامعة السوربون ومستشار الاتحاد الأوروبي. وأدار الجلسة الباحث والمفكر المصري نبيل عبدالفتاح، حيث تناول النقاش العلاقة المتشابكة بين الفكر العربي والفكر الغربي، واستكشف الرؤى المتبادلة بين الطرفين، في ضوء التحولات السياسية والفكرية الراهنة.
واتفق المشاركون على ضرورة تجاوز الخطابات الاختزالية في تناول العلاقة بين العرب والغرب، والعمل على بناء رؤى أكثر تعقيدا وعمقا، تستند إلى قراءة تاريخية متأنية، وفهم أوسع للمتغيرات الجيوسياسية والثقافية الراهنة.
استهل نبيل عبدالفتاح الجلسة بالإشارة إلى أن الغرب ليس كيانا موحدا أو ثابتا، بل هو فضاء متعدد ومتحول، مما يستوجب إعادة النظر في الطريقة التي يتعامل بها الفكر العربي مع الغرب. وأكد أن التصورات العربية السائدة عن الغرب تشوبها كثير من التناقضات والأساطير، مما يفرض ضرورة تفكيكها وإعادة بنائها وفق أسس أكثر واقعية وموضوعية.
من جانبه، ركز الدكتور عبدالإله بلقزيز على تأثير الأحداث التاريخية في تشكيل رؤية العرب للغرب، مشيرا إلى أن التفاعل العربي مع الحداثة الغربية بدأ مع حملة نابليون على مصر، وهو الحدث الذي أدى إلى انقسام النخب العربية بين تيارين رئيسيين: الأول تمسك بالأصالة والتراث الإسلامي، بينما تبنى الثاني مشروع العصرنة والانفتاح على الفكر الغربي، الذي أطلق عليه لاحقا التيار الليبرالي العربي.
أما الدكتور محمد المعزوز، فقد سلط الضوء على الأحداث الراهنة، مؤكدا أن “طوفان الأقصى” وما تبعه من تداعيات على القضية الفلسطينية، وضع العرب مجددا أمام اختبار حقيقي في علاقتهم بالغرب. وأوضح أن الغرب، الذي طالما شغلته “المسألة اليهودية”، أصبح اليوم أمام ما يمكن وصفه بـ”المسألة العربية”، في ظل تصاعد الوعي العالمي بالقضية الفلسطينية، والاحتجاجات المناهضة لسياسات الاحتلال.
وأشار عبدالفتاح إلى أن العلاقة بين الفكر العربي والفكر الغربي ظلت محل جدل منذ صدمة الحداثة وثورة التنوير الأوروبية، مرورا بميلاد الدولة الحديثة في عدد من البلدان العربية، مثل تونس، التي شهدت أول دستور عربي. وأوضح أن الأسئلة التي طرحتها الحداثة على الفكر العربي لا تزال قائمة إلى اليوم، خصوصا في ظل التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم العربي.
مقاربة العرب والغرب عند بلقزيز
يرى بلقزيز أن التيارين الفكريين الرئيسيين في العالم العربي تشكّلا تحت وطأة الشعور بتفوق الغرب، لكنهما اختلفا في كيفية التعامل معه. فمن جهة، اعتقد التيار “الأصالي” أن مواجهة هذا التفوق تكون بالاحتماء بالمرجعيات التراثية وإعادة إنتاجها، لصدّ التقدم الغربي والحفاظ على الهوية الثقافية. أما التيار الليبرالي، فلم يكن أكثر انسجاما، إذ انقسم بدوره إلى تيارين: الأول هو “الإصلاحي الإسلامي”، الذي مثّله مفكرون مثل رفاعة الطهطاوي، وخير الدين التونسي، وجمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، ومحمد رشيد رضا، وسعى إلى التوفيق بين التراث والحداثة. والثاني هو “النهضوي”، الذي ضمّ شخصيات مثل أحمد فارس الشدياق، وبطرس البستاني، وأديب إسحاق، وجورج زيدان، وفرح أنطون، وامتد إلى طه حسين، إذ رأى هذا التيار في الغرب نموذجا حضاريا متقدما، ينبغي للعرب الاستفادة منه لتحقيق التقدم وبناء المجتمع الحداثي.
بين القطيعة والاحتذاء
وفقا لبلقزيز، انقسمت النظرة إلى الغرب إلى رؤيتين متضادتين: الأولى تعتبره تهديدا حضاريا تجب مواجهته عبر تعزيز الهُوية المشرقية والإسلامية، والثانية ترى فيه نموذجا يجب الاحتذاء به لتحقيق المدنية المنشودة. ففي حين ينظر التيار الأول إلى الغرب على أنه خطر داهم يجب التصدي له، ينظر التيار الثاني إليه على أنه مرجع للتحديث ينبغي السير على خطاه.
مع نهاية القرن الـ18، لم يكن الغرب قد كشف بعد عن مشاريعه الاستعمارية بشكل واضح، ولكن مع بروز هذه المشاريع واتساع رقعة النفوذ الاستعماري، بات يُنظر إليه كرمز للهيمنة والعنصرية والاستغلال. ولم يقتصر هذا الموقف على التيارات السلفية، بل شاركت فيه التيارات القومية العربية، والبعثية، والماركسية، التي اعتبرت الغرب قوة استعمارية تسعى لإخضاع الشعوب ونهب ثرواتها.
في المقابل، ظلّ تيار عربي آخر يرى أن الغرب ليس مجرد قوة استعمارية، بل هو أيضا مهد النهضة والإصلاح الديني، والثورة العلمية، والديمقراطية، والعقلانية، والتنوير. غير أن الإشكالية الكبرى تكمن في أن كلا التيارين يرى الغرب من زاوية واحدة فقط؛ فإما أنه خير مطلق أو شر مطلق، بينما الحقيقة أنه كيان مركّب يجمع بين هذين النقيضين. فهو من جهة مركز للحداثة والتطور، ومن جهة أخرى، قوة تسعى إلى الهيمنة والتبعية.
يشير بلقزيز إلى أن الغرب يمارس في داخله قيم العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان، لكنه خارج حدوده يتحول إلى قوة استعمارية لا تعترف بحقوق الشعوب الأخرى. هذا الازدواج في السلوك جعله يظهر في صورة المتناقض، فهو في الداخل نموذج للتحضر، وفي الخارج قوة تفرض سيطرتها بوسائل الهيمنة والاستغلال.
يرى بلقزيز أن المشكلة ليست في الغرب ذاته، بل في الرؤية العربية المغلقة تجاهه، حيث يتم اختزال التجربة الغربية إما في صورة مثالية تُوجب الاقتداء بها، أو صورة شيطانية تُحتم العداء المطلق لها. ويؤكد أن العرب بحاجة إلى إخضاع رؤيتهم للغرب لنقد عميق، كما أن الغرب نفسه يحمل تناقضات صارخة تحتاج إلى تحليل دقيق. فمن جهة، لا يمكن الاقتداء بنموذج لا يعترف أصحابه بك كجزء منه، ومن جهة أخرى، لا يمكن الاستمرار في موقف العداء المطلق دون إدراك تعقيدات المشهد العالمي.
يستطرد بلقزيز في القول إن العلاقة بين العرب والغرب ليست مجرد صراع دائم، بل هي أيضا عملية تثاقف مستمرة. فمن خلال التأثر بالقيم الحديثة التي تطورت في الغرب بين القرنين الـ16 والـ19، تمكنت التيارات الإصلاحية والنهضوية في العالم العربي من دمج كثير من هذه القيم في النسيج الثقافي العربي المعاصر.
ويرى بلقزيز أن التثاقف هو أحد الأبعاد الأساسية في العلاقة مع الغرب، ويجب أن يسير جنبا إلى جنب نقد الممارسات الاستعمارية والتدخلات الخارجية. فلا يمكن إنكار المآسي التي خلفها الصراع مع الغرب في الماضي والحاضر، لكن بالمثل، لا يمكن إنكار الدور الذي لعبه التفاعل الثقافي في تطور الفكر العربي الحديث.
إشكالية القطيعة والتشويه
في المقابل، استعرض الدكتور محمد المعزوز تأثير الفكر الغربي على الفكر العربي، مشيرا إلى أن العلاقة بين الطرفين لم تكن تفاعلية بقدر ما كانت قائمة على محاولة إقصاء وتشويه الفكر العربي الإسلامي. يوضح المعزوز أن محاولات الغرب للتعامل مع الفكر العربي لم تكن بدافع البحث العلمي المجرد، بل كانت مدفوعة بغايات دينية وأيديولوجية، بدأت مع الكنيسة واستمرت مع الاستشراق الحديث.
تُظهر الدراسات التاريخية كيف أن الغرب لم يقتصر على استلهام الفكر العربي الإسلامي في العصور الوسطى، بل عمد في بعض الأحيان إلى تشويهه وتقديمه بصورة تتناسب مع التصورات الغربية المسبقة. ففي حين كان ابن رشد يهيمن على الفكر الأوروبي لأكثر من 4 قرون، جاءت محاولة إقصائه عبر تيار ديني مسيحي يهودي مشترك. وقد تجلّى هذا في أعمال الفيلسوف توما الأكويني، الذي لم يقرأ نصوص ابن رشد في أصلها العربي، بل اعتمد على الترجمات العبرية التي قام بها مفكرون يهود مثل ابن ميمون وإبراهام بن داود. وقد كانت هذه الترجمات انتقائية، حيث أعيد تفسير فلسفة ابن رشد بما يخدم الرؤية اللاهوتية اليهودية والمسيحية، مما أدى إلى إسقاطه من عرشه الفكري في أوروبا.
لم يكن إسقاط ابن رشد مجرد تراجع فكري، بل كان جزءا من مشروع أيديولوجي أوسع يهدف إلى نزع المشروعية عن الفلسفة العربية الإسلامية ككل. إذ عمدت الكنيسة الغربية إلى تكريس توما الأكويني كسلطان معرفي، وصُوِّر في الأعمال الفنية وهو يجلس على عرش الفلسفة، بينما يظهر ابن رشد في ظلال باهتة أسفل هذا العرش، في إشارة إلى تراجع الفكر العربي. لم يكن هذا مجرد عمل فني، بل كان تعبيرا عن توجه أوروبي يسعى إلى تقويض التأثير العربي الإسلامي في الفكر الغربي.
ومن أبرز محاولات التشويه الزعم بأن ابن رشد اعتبر الفلسفة مناقضة للدين، وهو افتراض خطأ تماما، إذ كان ابن رشد في الواقع أحد أبرز دعاة التوفيق بين الدين والعقل، وقد أسس لفكرة أن الفلسفة والدين ليسا في صراع، بل يكملان بعضهما بعضا. لكن توما الأكويني حاول أن يستحوذ على هذا الطرح ويقدمه وكأنه إنجاز للمسيحية الغربية، متجاهلا أن أصوله جاءت من الفكر الإسلامي.
لم يتوقف التشويه عند العصور الوسطى، بل امتد إلى العصر الحديث مع ظهور الاستشراق في القرن الـ18، حيث أعاد المستشرقون تصوير العالم العربي والإسلامي وفق رؤية نمطية مشوهة. تم تقديم النبي محمد، على سبيل المثال، كشخصية سياسية لا كرجل دين، ورُكِّز على جوانب شخصية مثل تعدد زوجاته بهدف التقليل من قيمته الروحية والدينية. كما تم تصوير الإسلام على أنه دين عنف وليس دينا للحضارة والتسامح.
إن هذا التحيّز الفكري والديني في التعامل مع التراث العربي الإسلامي لم يكن مجرد سوء فهم، بل كان جزءا من مشروع سياسي وثقافي يهدف إلى تكريس الهيمنة الغربية، وإبقاء العالم العربي في موقع التابع، بدلا من أن يكون شريكا في إنتاج المعرفة والحضارة.
يرى الدكتور المعزوز أن مراجعة العلاقة الفكرية بين العرب والغرب باتت ضرورية في ظل التحولات الراهنة، خاصة مع التحديات الكبرى التي تفرضها القضية الفلسطينية اليوم. ويؤكد أن العرب بحاجة إلى تجاوز حالة الشلل الفكري التي أوقعتهم فيها هذه العلاقة غير المتكافئة، عبر إعادة التواصل مع تراثهم الفلسفي والفكري، ليس باعتباره ماضيا جامدا، بل بوصفه مصدرا متجددا للإبداع والتفكير النقدي.
ويدعو المعزوز إلى ضرورة إنتاج خطاب عربي جديد يتجاوز ثنائية الانبهار المطلق بالغرب أو العداء الأعمى له، مشددا على أهمية استعادة المبادرة الفكرية، وبناء رؤية نقدية مستقلة تعيد للعالم العربي دوره في صياغة المعرفة وإثراء الفكر الإنساني.