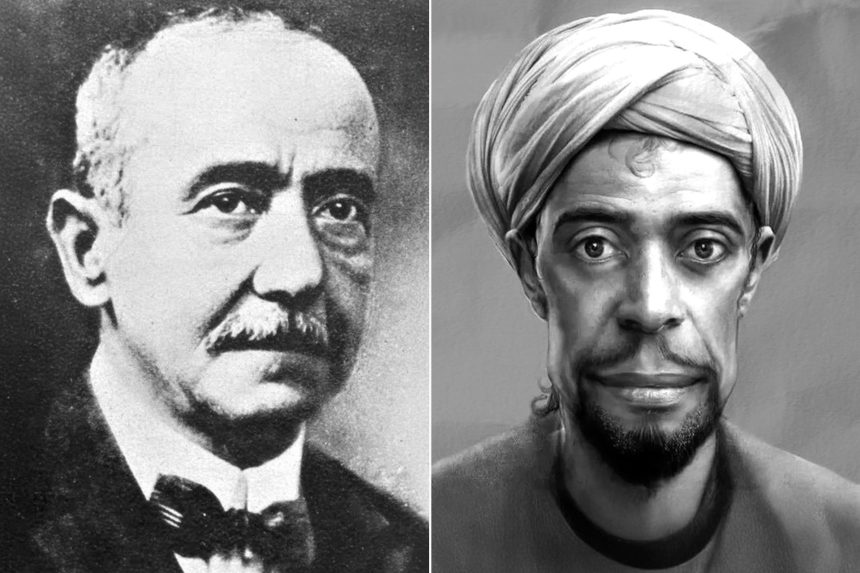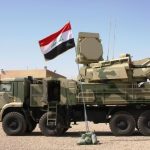“المعلم”، كلمة ما أعظم ترديدها، ويا ما أحيلى ترجيعها، غير أن حظوة الاسم لم تدرأ عن صاحبها حظ الاستهداف تعريضا وتنكيتا في نسخة التندر، التي كان لها ما بعدها من امتهان مجتمعي، وما بين يديها من تجن “سينمائي”.
وشتان ما بين إشراق صورة “توفية التبجيل” الناصعة التي أودعها الشاعر أحمد شوقي تضاعيف بيته السائر:
“قم للمعلم وفه التبجيلا
كاد المعلم أن يكون رسولا!”
وبين سخرية ريشة أبي عثمان الجاحظ الكاريكاتيرية اللاذعة، التي حاول أن يداري تحاملها بوضع مصطلح “معلم الصبيان”، الذي جعله مندوحة تكتيكية لإفراغ شحنة الاستهداف، ولم يكتف بذلك؛ بل ركب موج التسويغ لتصنيف كتاب عقده لـ”نوادر المعلمين” من خلال “نماذج عملية” و”مشاهدات حية”.. كما فعل حين ألف كتاب “البخلاء”، الذي أودعه “قصصا واقعية”، لا تعبر بالضرورة عن الخط العام لمجتمعاتها، رغم متسرب التعميم، الذي يفهم من تبويبه.
ومن منفذ “الموضوعية السطحية”، سوغ أبو عثمان إمضاء عزمه، وسوق إقدامه بعد الإحجام، حين ذكر قصة المعلم الذي زعم أنه عزز لديه الفكرة وأملى عليه تنفيذها، وحاصل القصة الغريبة وجوها السياقي أن الجاحظ عزم على وضع كتاب عن الحمقى وقوده “معلمو الصبيان”، ثم أدركته بقية من ضمير فاستنكف أن يؤلفه فيعرض بهم.. حتى تعرّف -ذات مرة- على معلم كُتاب (“الكُتَّاب” مركز تحفيظ الأطفال القرآن)، فعرف في وجهه الفضل وفي سمته الوقار وفي هيئته الهيبة، ثم انقطعت عنه أخباره -زمنا- فسأل عنه فقيل له إنه قد اعتزل في منزله وغشيه الحزن لفقد عزيز، فأتاه يعزيه، ثم سأله عن الفقيد: “هل هو أحد الوالدين أم أخ أم ابن؟”، فذكر له أنه ليس أحدا ممن ذكر، بل حبيبة اسمها أم عمرو، فرقَّ له وأراد أن يخفف عنه، ثم سأله عن شأنها، فأخبره أنه لم يرها، وإنما سمع مارا ينشد:
يا أم عمرو جزاك الله مكرمة
ردي علي فؤادي أينما كانا
لا تأخذين فؤادا تلعبين به
فكيف يلعب بالإنسان إنسانا؟!
ثم ذكر أن عشق أم عمرو دخل قلبه من سماع البيت، الذي لا يمكن أن تستحقه إلا امرأة ما في الدنيا أحسن منها، مضيفا أن الشخص ذاته مر -بعد ذلك- من أمام بيته ينشد:
إذا ذهب الحمار بأم عمرو
فلا رجعت ولا رجع الحمار!
“فاستنتج أن أم عمرو قد ماتت! هكذا بهذه السطحية!” ولعل الجاحظ -غفر الله له- قد “ألّف” هذه القصة ليجعلها مندوحة لتصنيف كتابه المتحامل، الذي مرر -في التقديم له- مسوغا هو أشبه بـ”الخدعة الذهنية” حين علل الحمق والغباء المعروض في “نوادره” بـ”معاشرة الصبيان!”، غير أن “مبرره” اصطدم بصخرة “فارق المقام” بين شخصيتي البخيل -التي أشرت إليها سابقا- والمعلم، إذ تأبى الفطرة والذوق “تعميم التجربة” التي ساقها بين يدي شروعه في “إصدار” الكتاب؛ ذلك بأن استهداف المعلم -في حد ذاته- “عدوان أخلاقي”، لما تحته من هدم لصورة المدرس عموما، ومدرس القرآن خصوصا، أما صورة البخيل فهي -في الكتاب الذي خصصه لها الجاحظ- جولة تفكه مستملحة لا تنقصها الاستساغة، ثم إن “عموم” تلك الشخصية مثل “خصوصها”، فهي لا تدفع عن نفسها، ولولا التجانف لإثم التسمية، وربط تلك المنقصة ببلدان بعينها -وشعوب بذاتها- لكان معه حق في الاستهداف.
ولو قيل إنه ليس لبخيل عرض، لكاد ذلك يكون مسلمة لا اختلاف عليها، لأن البخل سلوك شاذ عن سواء الفطرة.
ولقد جرت مياه نمطية كثيرة تحت جسر السخرية الجاحظية، فعرفت شخصية المعلم حالة تنازع بين مقام الرفع المثالي الذي دعا إليه شوقي في بيته الذائع، وبين درك الخفض السحيق الذي دشنه الجاحظ بتأليف نوادره “المركزة”.
غير أن “استيقاف” الشاعر الرسالي ظل حبيس “المحفوظات”، بينما انتقلت سخرية الكاتب العابث إلى دنيا الواقع ومشاهد التجربة، ولم تزل تربو وتستفحل، حتى ظاهرت بين درعي الاستخفاف الرسمي والنمطية المجتمعية، فنقصت “الهيبة” من أطرافها، وتقزمت أبعاد “الصورة”، فتدخلت يد “الرسمية” وأحلت لفظة “الأستاذ” قاموس التداول، بعدما صرفتها عن سياقها الذي أوردها فيه أبو الطيب المتنبي -عبر مديحياته السائرة- لتقذف بها في مجال التعليم وحقل التدريس، مدشنة بذلك -عن عرضي صدفة أو اتفاق قصد- جدار تمييز معنويا سميكا ينطق لسان حاله بالفرق اللقبي بين “المعلم” الذي يطلق -بالدرجة الأولى- على مقدم الدروس في المدارس “الابتدائية”، و”الأستاذ”، الذي هو أعلى درجة علمية جامعية.
كما يطلق اللقب الأخير (الأستاذ) -في موريتانيا بالتحديد- على مقدم الحصص التدريسية في الإعدادية والثانوية، وتختلف الدلالة الاصطلاحية لألقاب “المعلم”، و”المدرس”، و”المحاضر”، و”الأستاذ”، تبعا للعرف الرسمي المعتمد، والتعريف التخصصي الناظم.
ولأن الألقاب الثلاثة الأولى عربية فصيحة واضحة الدلالة، أتجاوزها إلى “الأستاذية” التي غادرها المعنى الذي حدها به المتنبي، بعدما خصتها غلبة الاستعمال بمراد “الرسمية” الذي جعلها مقابلا تمييزيا لـ”المعلم”.
وفي كلمة “المدرس” معنى ليس في لفظة “الأستاذ” فارسية الأصل، التي تدور حول ثلاثية: الزعامة والقيادة والبأس، وهي مزايا لا تناقض رسالة المدرس، لكنها منفصلة عن دوره “التهذيبي” ومهمته “التعليمية”، داخلة في ميدان السياسة والحرب والقتال والفروسية. واقرؤوا -إن شئتم- قول “مالئ الدنيا وشاغل الناس”:
أمساور أم قرن شمس هذا؟
أم ليث غاب يقدم “الأستاذا”؟
وقيله:
ترعرع الملك “الأستاذ” مكتهلا
قبل اكتهال، أديبا قبل تأديب!
ثم انظروا بم ترجعون عند المقارنة بين مراد أبي الطيب المعنوي، وبين الاصطلاح الوضعي الرسمي؟ ومن الجلي -الذي لا يحتاج إلى استرسال- أن أستاذية المتنبي تخرج من مشكاة مثالية شوقي، لا من كاريكاتيرية الجاحظ!