يتنبأ “أدب النهايات” العبري بنهاية مأساوية لإسرائيل، وقد اختلفت أسباب وسياقات هذه التنبؤات تبعا لاختلاف تموضعات هذه الأعمال ثقافيا وأيديولوجيا في المجتمع الاستيطاني والقضايا التي تشغل التيارات المخاطبة بالروايات، وتبعا لرؤى وتوجهات ووجهات نظر كتابها.
يرى الكاتب الإسرائيلي يشاي سريد أن “أدب النهايات” يشبه خريطة يصورها الكاتب للقارئ، فإذا كان هناك عشر نقاط على خط الزمن أو على الطريق، فنحن الآن في النقطة الرابعة، مثلا، ويجب الهرب من هناك قبل ضياع الوقت، أي قبل وصول الكارثة أو الوصول إلى الكارثة. وكأن هذه الأعمال لوحات رصد لأزمات المجتمع الصهيوني ومراحلها ومنحنيات تطورها ومحطات تصاعدها، التي ينبغي أن يعيها الجمهور ويتفاعل معها سلبا أو إيجابا أو إفلاتا.
تتفاوت القضايا والأفكار المركزية التي تدور حولها هذه الأعمال الأدبية، وتمثل محركات وخلفيات الأحداث والوقائع الفاصلة والخط الدرامي والاحتدام الوجداني وصولا إلى لحظة الكشف والوقوف أمام الحقيقة عارية تماما.
من هذه القضايا التطرف الديني كما في روايات الكتاب والروائيين: بنيامين تموز “فندق يرمياهو” (1984)، وإسحق بن نير “الملائكة قادمون” (1987)، وهادي بن عامير “من أجل الرب” (1998)، ويشاي سريد “الثالث” (2015)، وليو دي وينتر “حق العودة” (2008)، وبول ألستر “دولة أم عشيرة” (2020).
وقد تكون القضية هي السلطوية العسكرية كما في رواية عاموس كينان “الطريق إلى عين حارود” (1984) (ترجمها أنطوان شلحت)، أو سلطة أيديولوجية غاشمة كما في رواية آساف جفرون “هوس الماء” (2014)، أو الحروب الطاحنة بين اليمين واليسار كما في رواية إسحق بن نير “بعد المطر” (1979)، أو خراب تل أبيب وتحولها إلى معسكر تجميع كما في رواية عاموس كينان “الكارثة 2” (1975).
“2030”
وهناك أعمال أدبية يتكثف فيها محتوى الدايسوتوبيا (المدينة الفاسدة) والانهيار الأخلاقي والسيولة الشاملة مثل رواية يغال سرنا “2030” الصادرة في العام 2014، والتي عالجت القضايا السابقة وأضافت إليها الجشع والطمع والسرقة والانحطاط الإنساني والفساد الأخلاقي والاقتصادي والضعف العام، كخلفية تاريخية ثقافية اجتماعية، وتوقع بسببها نهاية إسرائيل. تدل هذه الخلفية على تحولات اجتماعية اقتصادية أحدثها الانتقال إلى الرأسمالية النيوليبرالية الجشعة مطلع هذا القرن، وأنتجت أسقامًا وأزمات واضطرابات.
تنطلق الرواية من لحظة احتجاجات اجتماعية غير مسبوقة شهدتها إسرائيل في يوليو/تموز 2011، إذ كانت الاحتجاجات السابقة مرتبطة بهويات اجتماعية وثقافية متعارضة ومستقبل الأراضي المحتلة، وعبّرت عن صراع سياسي، في حين كانت المصالح الفئوية مهمشة ولم تكن سببًا لمظاهرات مليونية حاشدة.
اندلعت الأحداث يوم 14 يوليو/تموز بمبادرة من دفني ليف، طالبة سينما نكرة، احتجاجا على ارتفاع أسعار السكن في تل أبيب، وأقيمت أول الخيام بشارع روتشيلد. بعد شهر من الاحتجاج، كان هناك مخيمات في 41 مستوطنة ضمت 2350 خيمة و20 ألف شخص يرفعون شعار “الشعب يريد العدالة الاجتماعية”، وتوالت مظاهرات حاشدة أسبوعية ويومية ضمت شرائح متعددة خلال أشهر الصيف.
حمّل المحتجون مسؤولية الغلاء لرجال أعمال ورأسماليين، مكنتهم الحكومة والكنيست (البرلمان) الفاسدان من حلب الدولة، وطالبوا بخفض أسعار الغذاء والمواصلات والوقود والسكن.
وكانت جماعة على “فيسبوك” قد نظمت في يونيو/حزيران 2011 احتجاجا بسبب ارتفاع سعر “الجبن القريش” (cottage) في إسرائيل، وانضم إليها 100 ألف متصفح. وكانت هذه أول حالة يتجمع فيها تنظيم افتراضي لمستهلكين بهذا الحجم لمحاربة الغلاء، ثم تبعتها احتجاجات على غلاء منتجات الألبان وسلع أساسية، وأصبحت نواة ثورة، واندمجت احتجاجات المستهلكين مع احتجاجات على فساد نخب الأعمال والاقتصاد والمال وتقسيم ملكية الغاز، وتطالب بـ”العدالة الاجتماعية”.
وكانت هناك لافتات كبيرة في شارع روتشيلد تقول “ميدان التحرير- ناحية روتشيلد”. وبلغت الاحتجاجات ذروتها في الثالث من سبتمبر/أيلول من العام ذاته بمظاهرة اجتماعية ضمت 400 ألف شخص، معظمهم من تل أبيب، لم تشهد إسرائيل لها مثيلا.
كرست رواية “2030” قضية غياب العدل الاجتماعي وتفشي الفساد الأخلاقي والاقتصادي، والعلاقات المشبوهة بين دوائر المال والحكم، بما فيها فساد رئيس الحكومة والكنيست، وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من تحلل الكيان الصهيوني وزواله في نهاية الرواية. وفي حين كان أباطرة الغاز والقِمار ينعمون بكل شيء في أبراجهم الزجاجية الفاخرة بتل أبيب، وبرعاية الحكومة، لم يجد المهمشون والضعفاء اهتمامًا.
الطريق إلى عين حارود
رواية الراحل عاموس كينان (1927-2009) “الطريق إلى عين حارود” (1984)، تحاول نزع ثوب القاتل عن الإسرائيلي، وتحويل الاحتلال إلى أزمة وجود، أزمة اعتقد الإسرائيلي أنها سيجد حلها في فلسطين لكنه اصطدم بالواقع القاسي، وبحقيقة وجود سكان لهذه الأرض وكونه دخيلاً ومحتلا. تتحدث الرواية عن حقبة متخيلة يقع فيها انقلاب عسكري في إسرائيل، تنتشر على أثره الفوضى والنزاعات الأهلية والاغتيالات حيث يحكم العسكر كل شيء.
يقرر بطل الرواية (الإسرائيلي) الفرار إلى يوتوبيا متخيلة تدعى “عين حارود”، المنطقة الوحيدة التي لم تصلها الحرب، لكن الذهاب إلى هناك يمرّ بمناطق سيطرة العسكر، محفوفا بالمخاطر والموت. البطل لا يعلم إن كان المكان متاحًا، أو إن كان المتمردون لا يزالون أحرارا أو أحياء. وما بين الهرب إلى “أرض الميعاد” و”عين حارود” خيط يكشف هشاشة وسفه الحلم الصهيوني.
الخروج من تل أبيب ليس خيارا سهلاً أو متاحا للإسرائيلي في الرواية، إذ يعترف البطل بأن مشكلته ليست في احتمال إطلاق النار عليه أو مواجهة المخاطر، إنما في كيفية التسلل للخروج من تل أبيب (التي تختصر المشروع الصهيوني). لذلك يستمر في التخفي والاختباء، كما لو أن كينان يسرد رواية الإسرائيلي المختبئ خوفا من الإسرائيلي.
يلتقي بطل الرواية بشابٍ عربيّ يدعى محمود، الشخص الموثوق الوحيد الذي يمكنه مرافقته في رحلته، فالوصول إلى عين حارود يحتاج إلى مساعدة الفلسطيني حصرا. فالبطل يدرك ألا فرصة لديه للوصول إلى الأمان سوى برفقة عربي، فالحل الوحيد هو مرافقة الفلسطيني للخروج من كابوس صنعه الإسرائيلي في الواقع! يختار كل من الراوي ومحمود اسمًا مستعارا واحدا وهو “رافي”، لكن هذا تملّص من الجريمة ومحاولة ليبدو الإسرائيلي ضحية كالفلسطيني!
وفي خضم الكارثة والمأساة، كان المنقذ الوحيد عين حارود، التي تذكرنا بـ”أرض الميعاد” أيضا، لكن الإسرائيلي هنا هارب من الحلم الصهيوني ليغدو الرحيل عن المكان الذي كان يجب أن يكون خلاصا من “العذابات” هو الحل الوحيد للنجاة. يقول البطل لمحمود “أعرف أن لديك سلاحا الآن، لكن إياك أن تطلق النار، فهذه الحرب ليست حربك”. وكأن كينان يقول إن على الإسرائيلي أن يجد الحل والفلسطيني ليس معنيا بهذا الحل، مما يعني أنه حتى في لحظة “صحوة” مفترضة ما زال الإسرائيلي لا يتقبل وجود الفلسطيني!
والحقيقة أن الكيان الصهيوني لا يحتاج لانقلاب عسكري ليتجلى بؤسه وتوحشه وفاشيته ولا إنسانيته إزاء ضحاياه، فجحيم الاستيطان والاقتلاع والإبادة بدأ منذ اليوم الأول للمشروع الصهيوني، والمتوالية النموذجية لهذا المشروع مضطردة متواصلة لا تنتج إلا مزيدا من الشر والظلم والهمجية. والقيادة التي بدأت بديفيد بن غوريون وفلاديمير جابوتنسكي ومناحيم بيغن، لا بد أن تؤول إلى نتنياهو وسموتريتش وبن غفير.
“حق العودة”
وكان الكاتب والروائي وصانع الأفلام اليهودي الهولندي ليو دي وينتر قد نشر روايته “حق العودة” في 2008، وتتنبأ الرواية بانكماش الكيان الصهيوني إلى منطقة تل أبيب وشمال النقب حيث مفاعل ديمونا النووي، عقب اضطراره للتراجع عن الشمال والجنوب والقدس، ليغدو “غيتو” يهوديا محصنا. لكن المفارقة الساخرة أن أحداث ووقائع هذه الرواية تدور في عام 2024!

يعزو المؤلف انكماش الكيان الصهيوني لضغوط قصف صاروخي متواصل أدى لهروب المستوطنين، وانهيار الاجتماع الإسرائيلي وانقسامه بين متشددين (دينيًّا) غيروا طابع الدولة العلماني واضطروا العلمانيين للهجرة لبلاد أخرى. وبقي يهود لهم سجل إجرامي وعجزة وجماعات تنتظر بهوس وقائع سفر الرؤيا (أحد أسفار “العهد الجديد” الحافل بنبوءات نهاية العالم)، وآخرون قرروا المكوث والدفاع عن الكيان.
يقول دي وينتر إنه ليس من الواقعية أن يكتب رواية تدور أحداثها في 2024، فتصف زيارة اليهود لمكة وإقامة أمراء الخليج بفنادق تل أبيب الفاخرة، واخضرار صحراء الأردن، وازدهار أحياء القاهرة الفقيرة، وانتشار السلام والسعادة بالشرق الأوسط. ويبدي قلقه من ألا يبقى من إسرائيل ما يشهد ذكرى قيامها المئوية؛ فعقب عقود من العنف والحروب والدمار، سيقرر يهود إسرائيل أنهم يحبون أطفالهم أكثر من دولتهم.
لكن ما الذي يمكن أن يحول وقوعه دون تحقق رؤية دي وينتر الكابوسية لمصير إسرائيل؟ معجزة كظهور المسايا اليهودي، أو ثورة “لا دينية” عربية وتلك معجزة أخرى لن تحدث!
عشيرة أم دولة؟
في 2017، أجرى الصحفي بول ألستر مقابلات مع مسؤولين بمكتب الإحصاء المركزي، المركز العصبي لحقائق وأرقام الحياة بإسرائيل. وبنهاية مقابلاته، وجد نفسه يتكهن بالمستقبل المحتمل للدولة الصهيونية، وأطلق العنان لمخيلته، والنتيجة روايته الأولى “عشيرة أم دولة”، الصادرة في 2020.
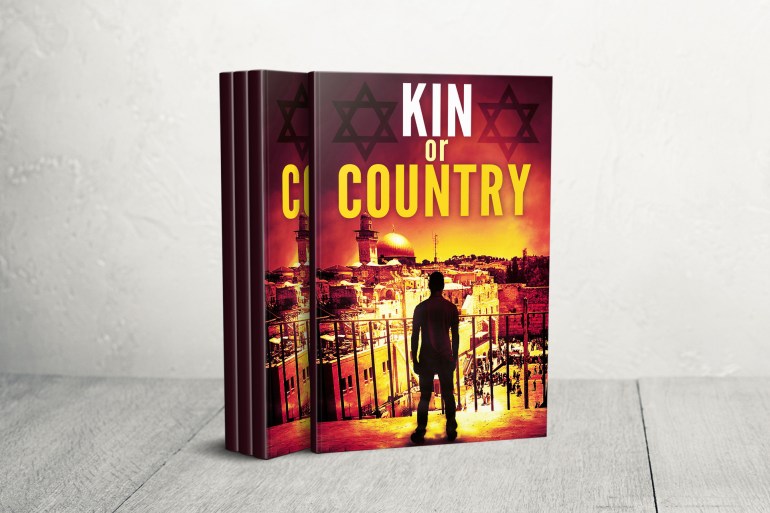
والرواية رحلة خيالية إلى عام 2048، وفي أواخر العقد الثالث من هذا القرن، وبعد اتفاق سلام بين إسرائيل والقيادة الفلسطينية، دُمج جزء من الضفة الغربية في دولة فلسطين الجديدة، وأصبحت القدس الشرقية عاصمتها. ووُضعت غزة تحت إشراف دولي، ووافقت دول عربية تؤوي لاجئين فلسطينيين على منحهم جنسيتها.
ونظرًا لأن الخلاف الإسرائيلي الفلسطيني لم يعد موجودا (آنذاك في الرواية)، فإن نقطة انطلاق ألستر هي الاختلاف الواضح في إسرائيل منذ نشأتها بين التطلعات السياسية وأسلوب الحياة الدينية للأرثوذكس المتشددين وتلك الخاصة بالعلمانيين. واتسعت الفجوة ليصبح الوجود السياسي والاجتماعي لكل جانب غير محتمل للآخر.
أصبحت القدس -ومستوطنات بالضفة الغربية وبلدات مجاورة- حريدية تقريبًا، وغدت أجزاء أخرى، مركزها تل أبيب، علمانية للغاية، وتستاء من فرض الأرثوذكسية عليها. فانتشرت الحركات السياسية، وكلها تؤكد أن طرفين متناقضين في الحياة غير متوافقين، وتطالب بالفصل.
أصبحت المطالب ملحة للغاية، والضغط السياسي قوي لدرجة أن الكنيست وافق على التصويت على استفتاء وطني. كان سؤاله الذي سيُطلب من الإسرائيليين التصويت عليه هو ما إذا كان ينبغي تقسيم الأمة إلى دولتين مستقلتين: دولة علمانية وأخرى دينية، الأولى عاصمتها تل أبيب، والأخرى مقرها القدس. يمر تصويت الكنيست، وتستعد الأمة لإجراء الاستفتاء، ثم تأخذنا الرواية في رحلة مدتها 11 يومًا متخيلا العد التنازلي للانتخابات.
أحد عشر يومًا حافلة بأحداث مأساوية. لا تتعلق فقط بالسياسة، بل بالموت أيضا. رغم أننا لا نشك في هوية الجاني المرتكب لعمليات القتل، فإن تحقيق الشرطة الذي يكشف ببطء عن الحقيقة يخلق توترًا خاصًا، ويرتبط ارتباطا وثيقًا بالمناورات السياسية مع اقتراب يوم الاستفتاء. هوية الطرف المذنب نعلمها فقط في نهاية الرواية، وهو كشف مليء بالسخرية. لكن جوهر الدراما يكمن في تقلبات المشهد السياسي وانعطافاته التي تترك نتيجة الاستفتاء ومستقبل الأمة اليهودية موضع شك.
يطلق الكاتب خياله في العوامل السياسية الاجتماعية الموجودة بالفعل بالمجتمع الإسرائيلي. فيفترض وجود مصالح بين الجناح الحريدي المتشدد والمناهض للصهيونية، ناطوري كارتا، والنظام الإيراني. تولد عن هذه العلاقة صفقة سرية بين إيران وحملة “نعم للانفصال” الحريدية. وكذلك الوضع السياسي بأميركا وتأثير أموالها على الاستفتاء. ويضيف قصصا إنسانية وعاطفية لأفراد محاصرين داخل اللعبة السياسية.
سؤال الرواية المتكرر: هل ستبقى الدولة اليهودية الوحيدة أمة موحدة أم أن هناك دولتين يهوديتين: واحدة علمانية وأخرى دينية. نتعرف على توقعات الكاتب في الصفحات الختامية. والنتيجة هي رؤية واقعية لرحلة إسرائيل إلى 2048، وتجربة أدبية مثيرة.
يقول ألستر عن الرواية “إنها تتوقع سيناريو قد يصبح واقعًا بسهولة في موطن لجميع اليهود، ما لم تحدث تغييرات مجتمعية جذرية في السنوات المقبلة. حيث تواجه إسرائيل بالفعل تحديات هائلة وفريدة. هذه قصة عن مخاطر التعصب والإكراه الديني، والأخلاق المعيبة داخل النخب السياسية، لكن بنهاية المطاف هي قصة عن مشاعر إنسانية وعلاقات أسرية تنطبق بالتساوي على الناس من جميع الأديان والمعتقدات والألوان”.
لكن ألستر لم يلتفت إلى أن الإكراه والقمع والاقتلاع لم يبدأ بظهور القوة الحريدية، بل بدأته وتعهدته الحركة الصهيونية وإسرائيل العلمانية، قبل مئة عام من زمن الرواية، ضد أهل فلسطين.
في القرن السادس قبل الميلاد، وقف النبي إرميا بن حلقيا على خرائب أورشليم بعد خرابها على يد نبوخذ نصر ملك الكلدانيين، وقف يرثي مملكة ومصيرا تنبأ به وحذر منه طويلا. ولكن بخلاف كُتّاب “أدب النهايات” الإسرائيلي، كان إرميا يحذر بني إسرائيل من الشر الحقيقي الذي عملوه في عين الرب، ويصف لهم سبيل توبة وإصلاح، لم يقع على آذان صاغية. أما الشر الذي صنعته إسرائيل الاستيطان الصهيوني، فلا يزال بانتظار من يحذر منه قبل الخراب القادم.









