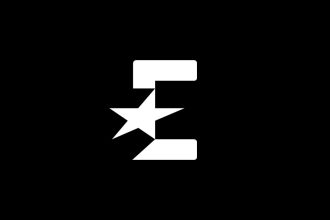في دفاتر الذكرى لدى الدكتور انويجي امراجع المسوري كثير مما يقال، ولكنه أيضا الكثير مما يدمي كبد الصخر الأصم، فخلال الأسابيع الماضية مرت بين يدي الغواص والأستاذ الجامعي مئات الجثث التي تمثل كل واحدة منها منهلا للدمع، ووجها للمأساة وعنوانا للكارثة التي حوّلت درنة من مدينة تغسل قدميها في الأبيض المتوسط، إلى عالم من الجثث والركام والثكل العابر للشوارع والبيوت.
ولم يعد “11 سبتمبر” مجرد يوم لذكرى ضربة البرجين الأميركيين فحسب، بل أصبح يوما العاشر والحادي عشر من سبتمبر، في ليبيا وفي مدينة درنة بشكل خاص تاريخ الموج الغاضب، وقصة قنبلة الماء التي حوّلت المدينة الشاطئية إلى بحر من الآلام.
جرف الماء كل ما في طريقه، وارتقى إلى المنازل الشاهقة، بعد أن ارتفعت عمائم الموج إلى أكثر من 30 مترا، وقضت على أحياء وعائلات، قبل أن يعود القهقرى، تاركا سياط الموت في وجنات درنة الدامية.
في مواجهة الكارثة.. مشاهد فوق الاحتمال
في الصباح الباكر قرابة الساعة 3:46 من يوم الفاجعة، بدأ الغواص والأستاذ الجامعي المتطوع بوحدة الإنقاذ البحري في درنة انويجي امراجع المسوري رفقة عدد قليل من الناس رحلة الإنقاذ، كانت الأصوات قد تعالت منذ غضبة الموج الأولى لكن سواعد الإنقاذ كانت أضعف من أذرع الموج القاسية.
يتحدث الدكتور انويجي للجزيرة نت عن مشاهد من الألم فوق التصور “انطلقت أنا وصديقي أبو بكر ساسي فجر يوم الاثنين الحادي عشر من سبتمبر، صوب المدينة، لنتفاجأ بهول الكارثة، ولنبدأ في رحلة الإنقاذ، وخلال أيام مرت بنا ذكريات لا تنسى وأهوال لا توصف”.
وبعد 10 أيام من مكابدة تلك الأهوال ما زال فريق المتطوعين من غواصين ومسعفين ومنقذين يواصلون مهمتهم الصعبة. يصر هؤلاء المنقذون على استعادة أكبر عدد ممكن من الجثث، ونقلها إلى الشاطئ، ليجدوا في باطن الأرض مثوى بعد أن أنهى الموج بعنفوانه قصة حياتهم.
كان مشهد الموت القابع في كل زاوية وكل شارع ومنطقة هو أول ما شاهده المنقذون القادمون لوسط المدينة في ذلك اليوم العصيب، كان يطل برأسه، حاملا معه أعدادا كبيرة من الجثث التي جرفها الموج الغاضب، وكانت المياه في ساعات الصباح الأولى من ذلك اليوم مرتفعة إلى مستوى فوق الفخذ، ومليئة بمادة البنزين والكيروسين.
ورغم صخب الموت الفاجع، فإن الصمت المخيف كان هو ما يسيطر على المشهد بحسب انويجي “في تلك اللحظة لم نسمع أصوات الاستنجاد، ولا نداءات الاستغاثة، خلافا لما كنا نتوقع، باختصار كان الجميع موتى، وكان العساكر ورجال الإنقاذ مذهولين من هول الموقف وفظاعة المظهر. كنا نسارع لتغطية أجساد السيدات أولا، وإيصالهن إلى أماكن تسمح لمن بقي من عائلاتهن التعرف عليهن ودفنهن بكرامة”.
الموت في كل مكان
ضمن مشاهدات انويجي يضج الألم بعنف عاصف “بالنسبة للأطفال الصغار كانت الجلود مفصولة عن هياكلها العظمية، ترى الجماجم واضحة، والعيون مبقورة، وبعض الجثث مقطعة، تجد رجلا فقط، أو ذراعا منفصلا، أو نصف جثة والبقية غير موجودة، وذلك نتيجة للانحصار بين الصخور، وتدفق الموج العالي، حيث أدى ذلك لانشطار الجثث إلى أشلاء”.
المباني والعمارات والأحياء التي عرفها الرجل تحولت فجأة إلى ركام، وأينما ولّى وجهه يجد المشهد ذاته “رجالا ونساء، كبارا وصغارا، شبابا وفتيات في مقتبل أعمارهم وربيع حياتهم، بعضهم ملقى على جوانب الطرقات، أو معلقا فوق الأشجار، أو مرميا فوق المباني أو في جنباتها”. وكأن الشاعر العربي القديم يصف تعامل الموت مع سكانها بقوله:
لا الموت محتقر الصغير فعادلٌ.. عنه ولا كبر الكبير مهيب
ويضيف “كان معظم الذين شاهدناهم خارج منازلهم عراة، لم يمنحهم الموج فرصة للاحتفاظ بتلك الملابس لتكون أكفانا على الأقل، أما الذين احتفظت بهم المنازل الغارقة، فقد سقط على أغلبهم الأثاث والدواليب والصالونات التي كانت مبعثرة كالألعاب متناثرة في كل الأماكن..”.
يتحدث الرجل المنقذ -والدمع يطغى على نبرته- “كانت العائلات عالقة داخل الطمي والوحل الذي جلبه السيل من الأودية، تلك المشاهد المروعة ما زالت وستبقى عالقة بأذهاننا.. “بعضهم مقطع الأوصال، أو نصف جثة، ما زالت لم تتحلل، الطمي يملأ الأفواه، والعيون غائرة، الشعر والملابس مليئة بالأتربة والرمال، مشاهد مروعة نسأل الله اللطف…”.
لن نتركهم في البحر
يرفع الدكتور انويجي أكف الضراعة إلى الله تعالى ليرحم شهداء درنة ويلقي برداء من الحفظ على مَن بقي من السكان، وخصوصا أولئك الذين نجوا من الموج، وكتبت لهم حياة أخرى ولكنها مفعمة بالمأساة وفقدان الأحبة.
يطالب انويجي المجتمع الدولي وكل من يمت للإنسانية بصلة، بمد يد العون لسكان المدينة، بشتى أنواع المساعدة.. لإعادة إعمار المدينة، ومساعدة من بقي من سكانها للعودة لحياتهم، فالمصاب كبير، والألم شديد، والمعاناة تفوق حجم وإمكانات الدولة، ووسائل الإنقاذ في المدينة ضعيفة ولم تكن مهيأة للتعامل مع أهوال كارثة كهذه.
كما يطالب بوسائل إنقاذ أكثر تطورا من ضمنها بالونات هواء وأسطوانات أكسجين، وزوارق مطاطية وبحرية قادرة على المساهمة في البحث عن الضحايا الذين رسبوا في قاع البحر.
ورغم صعوبة المهمة، وتضاؤل الآمال، فإن انويجي يكرر مرارا “لن نتركهم للبحر، نريد أن ندفنهم في الأرض، وأن نعرف قبورهم وأن نقف عليها داعين مستغفرين لهم.. لا نريد أن يلتهمهم البحر مرة أخرى”.
صراخ النسوة وهدير الموج
يتحدث رجل إنقاذ آخر هو أبو بكر ساسي رفيق الدكتور انويجي وشريكه في عملية الإنقاذ عن مشاهد أخرى لا تقل مأساة وألما عن سابقاتها، فقد كان الرجلان يتطوعان في مفوضية الكشافة، قبل يوم من الكارثة، حين كان الرعب يتسلل رويدا إلى المدينة بسبب الرياح والأمطار، والأنباء القادمة عن إعصار دانيال.
وكانت البداية -بحسب رواية ساسي- في الساعة 1:30 فجرا، “حين ورد إلينا بلاغ بوجود عائلة غارقة في “مصيف اجبل”، تمكنا من إخراجها، وعدنا لنسمع بعد ذلك بفترة قليلة صوت انفجار السد، تبع ذلك انقطاع تام للكهرباء عن المدينة، لتغرق بعدها في سواد دامس، وظلام موج عاصف، كانت أصوات الفيضانات مخيفة جدا، يشقها صوت الصراخ، وخصوصا أصوات النساء اللواتي تقاذفهن الموج مع أطفالهن وأسرهن، كما يطفو الزبد فوق الموج الهادر.
لقد تحطم الموج في الهزيع الأخير من الليل، وألقت الكارثة بـ”قنبلة مائية” على المنازل والشوارع، فطغى ماء السدود والفيضانات على الشاهقات والتقى مع مياه البحر على أمر قد قدر، ولم يكن من جارية ولا ذات ألواح ودسر لإنقاذ الغارقين.
وما الإصباح منك بأمثل.. إشراق على ركام الجثث
يتذكر أبو بكر ساسي -ومتى نسينا الموج حتى نذكرا- إشراقة الصباح، كان وجه المدينة الغارقة أكثر إيلاما من صراخ ليلها الهائج، كانت الشوارع بحرا هائجا من جثث الأطفال والنساء والشيوخ.
يضيف ساسي توزعت أنا وصديقي انويجي في مسارين، كان هو يحمل الجثث، وأنا أخرج العائلات الحية، وأسرع بها إلى مكان آمن مستخدما سيارة صديقي.
كانت الكارثة أكبر من حجم التوقعات، لكنها أيضا أكبر من حجم التحمل والصبر، ومن الصعب جدا أن ترى موجا هادرا لا يحمل معه الزبد والطمي بل الجثث والأشلاء.
يحكي ساسي عن العديد من مشاهداته المؤلمة وما عايشه في الأيام الماضية من مواقف تشيب لها الولدان، ويخلص إلى أن البحر لم يعد كما كان “قد كنت أقيم على شاطئه عدة ساعات أصطاد السمك، أما الآن فها هي شباك الموج تصطاد آلاف “الدرناويين”، وتلقي بهم إلى حيث يموت الأمل ويصعب الإنقاذ.. ما باليد حيلة، لقد جفت العيون وانشق القلب من الحزن” يقول أبو بكر ساسي.
السيارات المدافن.. عندما يتحول الإنقاذ إلى مأساة
في أحواض ميناء درنة يكتب الموت قصة أخرى، فمئات السيارات تحولت إلى قبور مغلقة على أصحابها، بسبب محاولات أعداد هائلة من الأسر الفرار في سياراتهم خلال اللحظات الأولى للكارثة، مما أربك حركة المرور، وقلل فرص النجاة، حيث شاءت الأقدار أن تجرفهم السيول جميعهم وهم في سياراتهم نحو حوض الميناء البحري، وإلى أعماق المياه.
وتحدث غواصون آخرون -وفقا لما أكدته مصادر من الهلال الأحمر للجزيرة- عن مشاهدة الكثير من جثث العائلات المأسورة داخل السيارات المغلقة في البحر، فضلا عن وجود عمارات كاملة ألقى بها الفيضان في مياه البحر، وهو ما زاد من صعوبة مهمة الإنقاذ، خصوصا بعد أن تحول شاطئ البحر إلى سور من الصخور والسيارات المحطمة.
وتذكر فرق إنقاذ متعددة أن ما تم انتشاله لا يزال ضئيلا مقارنة مع المفقود، حيث شاهد أحد فرق الإنقاذ الليبية أكثر من 600 جثة، كما ذكر مسعفون من مالطا أنهم شاهدوا مئات الجثث في عرض البحر، فيما انتشلت عشرات الجثث من عمق يتجاوز 120 مترا في قاع البحر.
وتعوق عمليات الإنقاذ ترسب آلاف الأطنان من الحديد والأسمنت وبقايا المنازل في عمق الماء، بعد أن جرفت شباك الموج المنازل القوية وألقت بها كقَشَّة في عمق البحر الهائج.
ووفق تقارير صحفية، فإن حوالي 8% من سكان المدينة باتوا في عداد الموتى والمفقودين، أما النازحون من المنازل المهدمة فقد فاقوا 40 ألف شخص، يعبر كل واحد منهم عن قصة من الرعب والحزن واليتم والثكل، فيد الموج الغاضب ضربت بعنف في كل بيت بالمدينة، ومزقت جدار كل صبر منيع.